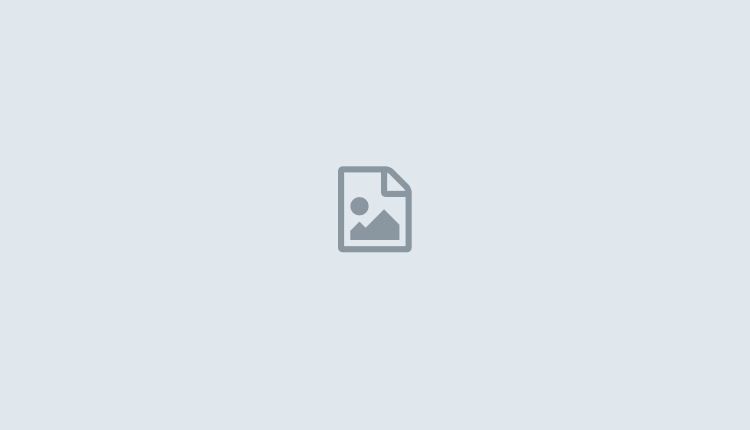كتبت/ سالي جابر
عندما نعلم بغزو عسكري علينا فإننا نعد له القوة والعِتاد لنستطيع مجابهة الخطر القادم علينا، الخطر المتمثل في آلات ومعدات، نستطيع أن نعلم متى يبدأ الغزو، ونستطيع أيضًا التحكم في وقت انتهائه، هو غزو يقتل الجندي في المعركة، ويمكننا بناء تمثال تمجيدًا للجندي الذى ضحى بروحه من أجل الوطن والعزة والكرامة، أو تسمية شارع باسمه أو مدرسة باسم الشهيد الفلاني، نعلم جيدًا من ضحى من أجل العزة والرفعة، ورفرفة علم على أرضه، لكننا نجهل بأنواع الغزو الأخرى التي أهمها وأخطرها على الإطلاق الغزو الثقافي؛ غزو الفكر وهدم اللغة، وهو ما لا نعلم بدايته، ونجهل كيف تكون نهايته؛ بل والأخطر أنه يمر بين أيدينا وينساب كمرور المياه، نجهله ولا نشعر به.
لدينا قوة عسكرية لا يمكن غزوها، ولذلك قاموا بغزونا ثقافيًا وكان ذلك بتحطيم اللغة داخلنا، أي تحطيم الهوية والثقافة، فإن اللغة هي هويتنا وثقافتنا ودرعنا صوب المخاطر.
فإن إضعاف اللغة العربية من شأنه إضعاف السيادة الوطنية، باسم مصطلحات تجذب العديد من الفتيان والفتيات؛ باسم العولمة التي تعمد على تدريب الهوية والثقافة، وتعمل على تزييف الوعي.
حتى أصبح الشباب يتحدثون على مواقع التواصل الاجتماعي بحروف اللغة اللاتينية المعروفة باسم( الفرانكو) وعمل ذلك على إبادة اللغة العربية، فإذا قرأ الشباب اليوم آيات القرآن الكريم وجدته يتلعثم، ويستصعب الكلمات.
فماذا فعل بنا الغزو الثقافي، وكيف، وبأي الطرق يمكننا التغلب عليه؟
لغة الشباب اليوم أصبحت لغة غريبة جدًا، حتى وصل الغزو لطريقة اللبس ووصل إلى التفكير، كل دولة تُستعمر تتحدث بلغة الدولة المُستعمَرة، وذاك تخطيط ثقافي جيد لمحو اللغة الأم لتلك الدولة، تمهيدًا لمحو ثقافتها وحضارتها والسيطرة عليها، فنجد في الجزائر- بلد المليون شهيد- يتحدثون اللغة الفرنسية وبطلاقة، رغم استشهادهم في الغزو العسكري؛ لكنهم فشلوا فشلًا ذريعًا في الغزو الثقافي.
ومصر عندما كانت مستعمرة إنجليزية كانت تتحدث اللغة الإنجليزية، للقضاء على الهوية والحضارة.
وإلى اليوم نتحدث ببعض المصطلحات الدخيلة ونحن لا نعلم حقيقتها لغويًا مثل:( فلوكا، ساندوتش،….. وغيرها من الكلمات)
جهلنا بالكلمات وتشكيلها وبلاغتها حتى حولنا معنى الجملة على النقيض، هيا بنا نقرأ بعض آيات القرآن الكريم لنعلم الفرق والتغيير في المعنى لمجرد تشكيل الكلمة.
قال تعالى في كتابه العزيز:” لقد تبرأ الذين اتُبعوا من الذين اتَّبَعوا …”
” إنما يخشى اللهَّ من عباده العلماءُ” وقع الفاعل هنا على كلمة العلماء؛ أي أنهم من يخافون الله، وتغير الضمة إلى فتحة غير معنى الآية .
وإذا قرأنا بعض أبيات الشعر الجاهلي لوجدنا من البلاغة ما يجذبنا إلى اللغة بشدة، فقال أحد الشعراء في هجاء بني نُمير:
“ولو وُزِنت حلوم بني نُمير على الميزان ما وزنت ذُبابة”
وقال المتنبي:
” أَلَمٌ أَلَمَّ ألم أُلِمَّ بدائه…. إنْ آنَّ آنٌ آنْ آنُ أوانه”
هي نفس الحروف بتغيير التشكيل، ويعني هذا البيت بوجود ألم لدى شخص لا يعرف مرضه، ولكن يحين الشفاء عندما تبدأ بالأنين والتوجع.
وهذا هو الإعجاز اللغوي الجميل، وهناك الكثير والكثير من الجمل التي ذُكرت في القرآن الكريم تقف عاجزًا عن جمالها ورفعتها، فإن من لذتها تفتخر باللغة العربية، لغة الضاد
وللحفاظ على رونق اللغة العربية وجمالها؛ نحتاج لبناء الإنسان فكريًا وثقافيًا، نحتاج لتجديد في لغة الحوار، والخطاب الديني، والفكر الديني والثقافي والاجتماعي.
علينا أن نتمسك بالموروث الحضاري، ونفهم أن الانفتاح على كل ما هو جديد لا يتناقض مع ثوابتنا التي تأسست على الهوية والثقافة.
وإعادة بناء الأجيال، وعودة الكتاتيب بصورة تتناسب وعصرنا الحالي، والاهتمام بالمؤلفات التي تبتعد عن عين الرقابة، ومنع صدور الكتب التي تحتوي على لغة ركيكة، وتعلم اللغة بطريقة صحيحة، والعلم بأن حتى اللهجة العامية لها أصول، وليست الكلمات المتداولة في الشارع.
ومن أجمل القصائد التي قيلت في اللغة العربية، قصيدة اللغة العربية تنعي حظها لشاعر النيل حافظ إبراهيم حيث قال:
رجَعْتُ لنفْسِي فاتَّهمتُ حَصاتِي
وناديْتُ قَوْمِي فاحْتَسَبْتُ حياتِي
رَمَوني بعُقمٍ في الشَّبابِ وليتَني
عَقِمتُ فلم أجزَعْ لقَولِ عِداتي
وَلَدتُ ولمَّا لم أجِدْ لعرائسي رِجالاً
وأَكفاءً وَأَدْتُ بناتِي
وسِعتُ كِتابَ اللهِ لَفظاً وغاية
ً وما ضِقْتُ عن آيٍ به وعِظاتِ
فكيف أضِيقُ اليومَ عن وَصفِ آلة ٍ
وتَنْسِيقِ أسماءٍ لمُخْترَعاتِ
أنا البحر في أحشائه الدر كامن
فهل ساءلوا الغواص عن صدفاتي
فيا وَيحَكُم أبلى وتَبلى مَحاسِني
ومنْكمْ وإنْ عَزَّ الدّواءُ أساتِي
فلا تَكِلُوني للزّمانِ فإنّني
أخافُ عليكم أن تَحينَ وَفاتي