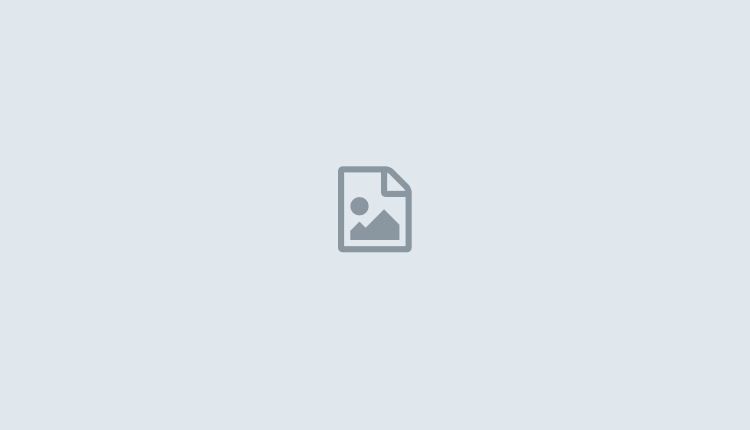بقلم/ حسن محمد
وجدتني بالبيت القديم جالسا أمام جدي وجدتي، كانا يجلسان، جنْبًا إلى جنْبٍ على أريكته، يسبحان الله.
كانت السيدةُ أمال آيةً في الحُسن والجمال؛ ترتدي عباءة مُزدانة بالورود ومُزرْكشة بألوان بهيجة، وتلتفُّ بطرْحةٍ من الحرير تدوِّر وجهها كالبدر في الإشراق. أما من يدها تتدلّى سبحتها البنية العتيقة.
أما السيد حسن كان يرتدي جلبابا ناصع البياض بحق، وفوق سماء عينيه استقرت قلنسوةٌ آخذت شكل زَّخْرفة الأرابيسك، وشاربٌ جميل ك أحمد مظهر، وكعادته لا تفارق سبحته البيضاء يده، غير أني لم أرَ الشيبَ منهما مستقرا؛ كأنهما في مقتبل العمر! وتابعت حديثهما في صمت على أريكتها المقابلة، والحاج يقول:
-أخاف أن أترككِ وحيدة.
-على فين العزم يا خويا؟
فرفع سبابته إلى أعلى ولم ينبس، فأكملت:
-بعد الشر عنك يا راجل!
-بارك الله في عمرك يا حاج. قلتها وقد أوْجَستني رجْفةٌ خفِيَّة.
-لا أحدٌ لها بعدي.. فليس لنا إلا بعض.
فتبسّمت ضاحكة وربتت على كتفه، قائلة:
-ربنا يخلِّيك ليّ يا أبو علي.
-إنكما لن تفترقا أبدا عن بعض..
فتبسّما لي، وفي نفسي أكملت: وإني أخاف فراقكما.. وفراق آخر صورة للإخلاص والوفاء في الحبِّ.. وأخاف لو رحل أحد منكما، لن يتحمّل الآخر.. ولن احتمل أنا!
وبعدها تبينتُ لأدرِكَ الحقيقة الأليمة. آه، لمَ الواقع يحب أن يعكّر صفْوة أحلامي دائما؟، ورحت أسأل لتحقيق الطمأنة بعد الخوف:
-أليس الآن مقعدكما الجنة؟
-بلى..
فابتهجت وقلت راجيا:
-لا تنسوني أبدا منكما!
وصحوت غارقا بدموع غزيرة حارقة من نيران الشوق، آجِنةٍ من طول مُكْثِها في حدقة الحنين.