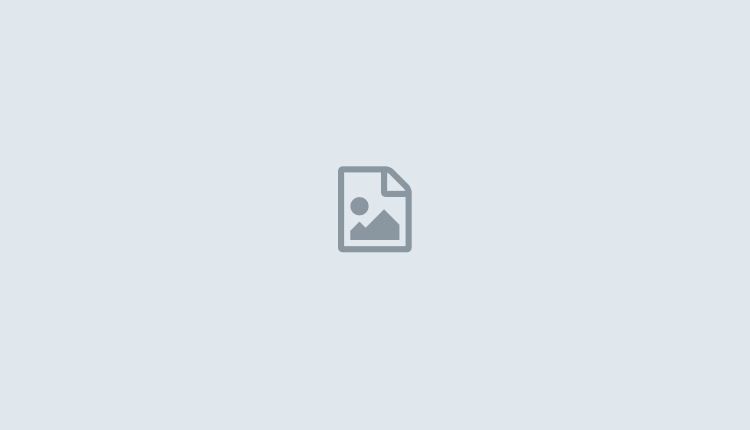بقلم/ مودَّة ناصر
يقول الشاعر سامي أحمد الموصلي:
“جمالٌ فوق ما وُصفَ الجمالُ
وحسنٌ ليس يشبههُ مثالُ
جمالُ الربِّ أبدعهُ بكونٍ
يكيلُ بهِ الجمالَ ولا يكالُ
وحسنُ الربِّ في الدنيا فريدٌ
لديهِ ولا امتثالَ فلا مثالُ
بديعُ الصنعِ أعطى كلَّ شيءٍ
حقيقتَهُ، ففاضَ بها الكَمالُ”
حينما ينظرُ الصغيرُ إلى عصفورٍ يسكنُ عشًّا، أو قمرٍ ينيرُ سماء ليلٍ، أو زهرةٍ تنامُ على غصنٍ؛ تحضرُ عيناهُ في عالمٍ بعيد، وكأن الطبيعةَ تُحدّثه وتتبسمُ له، وأفكرُ متسائلةً: يا ترى فيما يُفكر؟، ما الذي يراهُ ولا نراه؟، وأودُّ لو أتخطى عقله الصغير إلى ما فيه، هذا العقلُ المُصطفى في الحداثةِ ببراءة الفِطرةِ، ودهشة اكتشاف العالم بعنايةٍ إلٰهيّةٍ نقيّة. كلُ ما أدركه أنه الآنَ يتلقنُ أول دروس الطبيعةِ بسجيته الخاصة، ورؤيته التي تخصه -وحده- رغم صِغره، وأنه ثمَّة عملٌ للطبيعةِ في هذا الإنسانِ لا يعلمه سواهما.
يقولُ الرافعيُّ في كتابه “حديث القمر”: (كل ما في الطبيعةِ جميل، غير أنَّ الإنسان لم يتسع بعد في درس علم الجمال بمقدارِ ما يسع هذا العلم الجميل.)
أقرأ هذا وأسألُ الجمال: كيف نسلُك إليك سبيلاً؟، ألك علمٌ نتعلمه؟، أم أنَّ فلسفةَ الوصول إليك هو سير السبيل الذي ندركه إلى الجمال؟.
وإن كان الجمالُ غايةً تُدرك، فإن الطبيعةَ لغة هذا العلم، اللغةُ التي يتعلَّمها أهلها، ويمارسون جمالها ودلالها في ذات الآن، تلك اللغةُ التي لا تمضي بك إلى طريق النور وحده، وإنما هي بكونها نورٌ جماليٌّ بديع. نورٌ يفتحُ الله به على كلِ سائلٍ، وبابُ المسألةِ التأمل. تلك الرحلةُ البديعة التي لا تحتاج أن تسأل فيها؛ المتعةُ في الرحلةِ أم الوصول؟؛ لأنَّ السائر بطريقٍ إلى نعيم لا يُدرك النعيمَ الأكبر دون المرورِ بالأصغر، وكأن العالم صار جنَّةً بالدنيا ومنتهى بجنَّةِ الآخرة.
لا مُتأمِّل وحيد، ولا جاهل مُتأمل، أولٰئك المتأملون بقلوبهم العقلية وعقلهم القلبيّ، الموفون بالكيلِ والوازنون بقسطاسٍ مُستقيمٍ، بين عقلٍ فيه أثرٌ من طُهر قلبٍ، وقلبٍ به إحسانٌ من رجاحة عقلٍ. ولأنه لن تجد لسُنَّة الله تبديلاً ولن تجد لسنته تحويلاً؛ فإن سبيل الإنسانِ إلى دروس علم الجمال، هو البدايةُ من حيث السريرةُ النقيَّةِ، والتأملُ بقلبٍ يجاهد التبصُّر، سائلاً العناية الإلٰهية أن تكون رفيقًا.
هذا الطفلُ الكبير، الذي يحنُّ إلى طفولة قلبه دائمًا، حتى يلوذ بها، ينبغى أن يطوف حولها دائمًا. وأحاديثُ الطبيعةِ كثيرةٌ عذبة، قصائدٌ كونيةٌ قوافيها تسابيحٌ ساكنة، دموعها خُلقت بماء النور، سعادتها تشبه ابتسامة الملائكة، هي الرحبةُ بلا ضيق، لا تسعها ألف كنايةٍ أو تشبيه. وأذكرُ إبراهيم -عليه السلام- الذي سار باحثًا عن الله، وقال لا أحبُّ الآفلين؛ الطبيعةُ هي خلقُ الله الباقي والواجد، الذي إذا شاء جعل الليل سرمدًا أو النهار سرمدًا إلى يوم القيامة، الله القائلُ ” أفلا يتدبرون؟، أفلا يعقلون، أفلا يبصرون؟”
هي أنسٌ جميل، يتسنّى فيها بهاء الأحبِّة، فلا يروحون مهما بعدت ذكراهم، هي اللغةُ الجميلة، رحبةُ السجايا، القريبةُ والكريمةُ بالوصلِ، جمالٌ لا يفنى، وله من طرق الدلال ما لا ينفد،
هي الجمالُ والسبيلُ إليه، الطريقُ الذي يحتضنُ سالكيه.
إلى الجمال،..
كُن واسعًا وضُمَّني،
كن سمائي، وموطني.
وأختتمُ بقول حافظ إبراهيم:
جَمالُ الطَبيعَةِ في أُفقِها
تَجَلّى عَلى عَرشِهِ وَاِستَوى
فَقُل لِلحَزينِ وَقُل لِلعَليلِ
وَقُل لِلمَولي هُناكَ الدَوا
وَقُل لِلأَديبِ اِبتَدِر ساحَها
إِذا ما البَيانُ عَلَيكَ اِلتَوى
وَقُل لِلمُكِبِّ عَلى دَرسِهِ
إِذا نَهَكَ الدَرسُ مِنهُ القُوى
تَنَسَّم صَباها تُجَدِّد قُواكَ
فَأَرضُ الجَزيرَةِ لا تُجتَوى
فَفيها شِفاءٌ لِمَرضى الهُمومِ
وَمَلهىً كَريمٌ لِمَرضى الهَوى