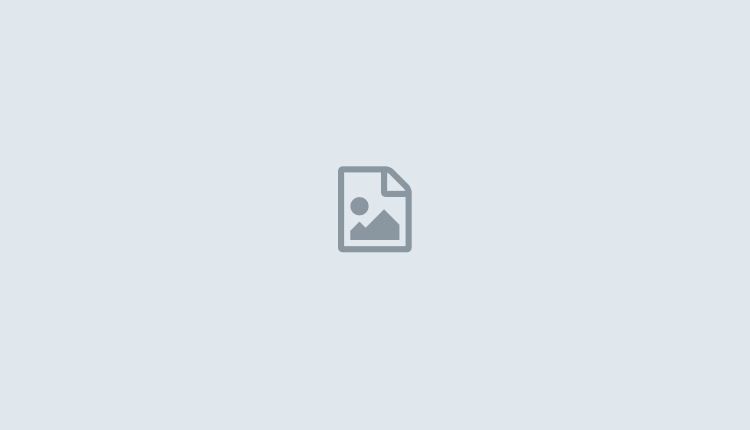بقلم/ شروق صالح
ظلام دامس يغطي المكان والثلوج البيضاء تكسو الشوارع والمتاجر وتهطل عليَّ فتصيب جسدي بالارتجاف وتفقدني الشعور بأطرافي وفوق هذا كله رياح عاتية تضربني بقوة وتصفع وجهي.
أطالع هاتفي فأجده يشير إلى درجة حرارة إحدى عشرة تحت الصفر.
تنهدت تنهيدة لأنني من عشاق الشتاء وحلمي رؤية الثلوج ولكن ليس بمثل هذه البرودة.
أسير بين الطرقات محاولة اكتشاف أين أنا، كل ما أذكره أنني كنت بمقربة من منزلي والملل يعتريني فلفت نظري ذلك الباب الخشبي المزخرف بشرائح من المعدن كأنه من عصور قديمة محفور داخله رقم (١٠٣٣)، تعجبت من ذلك الرقم في بادئ الأمر، لم أشعر بيدي إلا وهي ممسكة بقبضته الحديدة وتدفعه للخلف، دلفت من خلاله، فاختفي فجأة في لمح البصر كما ظهر.
أكملت سيري فإذ برجلين في العقد الخمسين أحدهما يرتدي مئزراً ملطخاً بالدماء، حاملاً بين يديه سكيناً ينعكس عليها ضوء القمر وأمامه الآخر مرتدياً ملابس مصنوعة من شوال البطاطس، يرتجف ويمسكه آخرون.
صرخ الرجل الأول إنها نهايتك يا كاسبر فلم يخلق بعد من ينصب عليّ،
ويقترض المال مني ولا يرده، ثم ركض بسرعة البرق ودب السكينة داخل صدره فأطلق كاسبر صرخة مدوية سالت على إثرها الدماء من قلبه أثناء خروج السكينة.
أصابني الذعر وركضت مبتعدة عن المكان، لا أدري كيف شعروا بي وركضوا خلفي قائلين: إنها ليست من مملكتنا (مملكة الزمرد) فلنقبض عليها ونسلمها للملك.
أكملت ركضي واستطعت أخيراً الاختفاء عن أنظارهم.
كانت الثلوج لازالت مستمرة بالهطول فوقع عيني على متجر به معطف بلون البندق ذو خامة تشبه الجوخ، مزوداً بقطع مع الفرو والأناقة تشع منه، اعترتني رغبة جامحة في اقتنائه، وضعت يدي داخل جيبي باحثة عن النقود لأجدها (١٦٨) لكنها ليست كنقودنا بل نقود غريبة فقد تبدلت فور مروري لهذه الحقبة الزمنية.
دلفت من باب المتجر وسألت عن ثمنه فأصابتني الصدمة فقد كان (٤٠٥)!!
ضحكت بسخرية قائلةً: إنني مفلسة سواء في زمني أو زمن غيري، فغادرت والحزن يعتريني.
أكملت سيري وإذ بيدٍ تجذبني من ذراعي قائلة: لقد أمسكتها.
غمرني الخوف صارخة فيه: اتركني يا هذا.
وما هي إلا لحظات لأجد سيارة تجرها خيول ينزل منها رجال ذو ملابس عسكرية يصطفون بمحاذاة بعضهم البعض ثم ينحنون وأنا مسحوبة من يدي لداخل العربة.
في تلك الأثناء أصبت بشلل مؤقت ولم يكن باستطاعتي الحديث أو الصراخ، أصابني الصمت التام.
بعد برهة من الزمن ترجلنا من العربة ودلفنا قصر ضخم ذي أشجار شاهقة الارتفاع، تملأه تماثيل لشاب يبدو أنه حاكمهم.
بعدها انتقلنا إلى رواق ضخم ينتهي بغرفة بها الكثير من الستائر الحريرية، في آخرها كرسي فخم كتلك الكراسي الخاصة بملوك العصور القديمة، يجلس عليه شاب غاية في الوسامة.
انحنى الجنود مُلقين بي أمامه، فقال أحدهم: “جلاله الملك إنها دخيلة على مملكتنا.”
نظرت إليه وأنا جاثية على ركبتاي ليقول “من أين أتيتِ؟ وما هي نيتكِ؟”
أخذت نفساً عميقاً وبدأت بسرد ما حدث معي وفور انتهائي من ذلك رفع صوته قائلاً: “كاذبة”
صرخت: “لست كاذبة، لم أكذب عليك؟”
قاطعنا مستشاره الخاص قائلاً “بعد إذن جلالة الملك، لو افترضنا أن ما تقوله هذه الفتاة صحيح إذاً يجب علينا تدمير تلك البوابة، على الرغم من أن ذلك مستحيل، أما الآن سنعطيها الاختبار وبناءً عليه سنحدد هل نطلق سراحها أم لا”
ابتسم الحاكم ابتسامة خبيثة أظهرت بعضاً من أنيابه متحدثاً بصوت جهوري “ما هو عمري؟ وإن أخطأتِ في تحديده الذي يجهله جميع من في مملكتنا ماعدا مستشاري الخاص سوف تقتلين بلا شفقة”
ابتلعت لعابي فلست بارعة في تحديد الأعمار لكن مظهره لا يعطي أكثر من (33) فكدت أنطق بها لكن لفت انتباهي ذلك الكأس الموضوع بجواره ويحتوي على مشروب بلون النبيذ لكنه ليس بنبيذ.
قاطعني المستشار قائلاً: هيا سينفذ الوقت، فليس من طبع جلالته انتظار أحد.
أمعنت النظر في وجهه الذي يأسر القلوب من شدة جماله ووسامته وتذكرت أنيابه التي رأيتها وذلك الكأس فتيقنت أنه ليس بشري، بل مصاص دماء ممن أراهم في الأفلام وأقرأ عنهم في الكتب فاستجمعت شجاعتي محدثة نفسي: حتى وإن أخطأت لا يهم فمعنى ذلك أن حياتي قد انتهت، فقلت بصوت مرتفع: (١٠٣٣).
علا الغضب وجه الملك وصرخ المستشار قائلاً: من أنت؟
نهض الحاكم غاضباً وأردف قائلاً: زجوا بها في السجن.
فقلت بتوتر: لم؟
صرخ فيّ: كيف تمكنت من معرفة ذلك؟
أجبته ببساطة نسبة لذلك الباب الذي عبرت منه، كما أنك لست بشري مثلنا.
صرخ مطالباً إخلاء القاعة من الجميع ولم يلبث فيها غير ثلاثتنا، أنا وهو والمستشار، ثم اقترب ببطء إليّ وأنا أتراجع للخلف، قائلاً: سأفتح لك الباب للعودة إلى موطنك، وفي لمح البصر وجدته أخرج سيفه قاطعاً رأس مستشاره فتناثرت الدماء في الهواء، مكملاً حديثه: كان الواجب عليّ قتل هذا الخائن الذي يفتح أبواباً ليأتي منها الغرباء فهو الوحيد غيري القادر على فتح البوابات بين العوالم و الأزمنة المختلفة، أما الآن سأوضح لك سر ذلك التاريخ الموضوع على الباب إنه يوم مولدي الذي أطلقه والدي على البوابات التي نعبر بها عبر العصور المختلفة لإحضار أشخاص نتلذذ بشرب دمائهم وهو يتبدل كلما تقدمت بالعمر.
وما أن أنهى حديثه، شاهدت الباب أمامي فعبرت منه وعدت إلى موطني أخيراً بسلام.