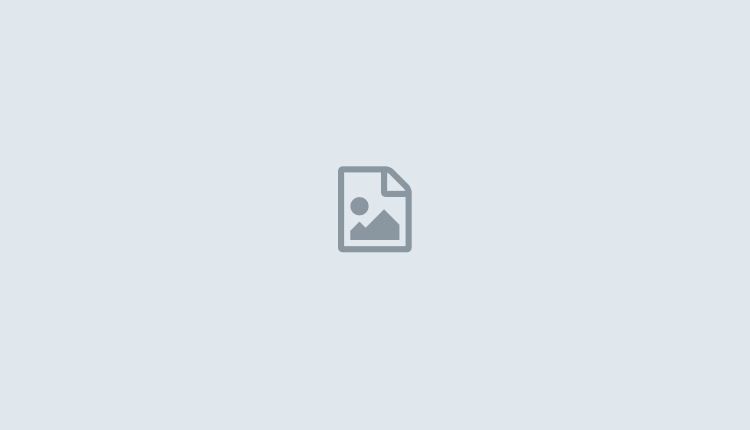رشا فوزى
استيقظت من نومي على صوت دقات ساعة الحائط تخترق أذني مختلطة ببقايا صوت أمي يرن داخل عقلي نابعاً من ذكرى قديمة ممتزجة بأضغاث أحلام :
-البنت ليس لها سوى بيتها وزوجها!
نظرت حولي بفتور، وأنا مازلت مستلقية على الفراش،
أتمتم:
– هذا هو بيتي!
ثم وأنا ألتفت إلى صورة زواجي المعلقة
على الحائط:
– وهذا هو زوجي، فلتهدئي بالاً وتستريحي!
نهضت من فراشي بآلية متجهة صوب باب حجرتي، وقبل أن أبلغه حانت مني التفاتة إلى المرآة؛ لأرى امرأة غريبة عني، تنظر لي بعينين خاملتين لا بريق فيهما، محاطة ببوادر تجاعيد تعلن باستحياء عن بداية خريف العمر، في حين شعرها الأشعث يحيط بوجهها الخالي من التعبير فلا ينم عن فرح، أو حزن، أو أي شعور آخر، اللهم إلا الإرهاق الذي ينطق به كل جزء من ملامح وجهها بوضوح.
اقتربت من صورتي في المرآة أتأملها عن قرب، وكأنني أراها لأول مرة، لاحظت بعض الشعيرات البيضاء تتسلل محاولة غزو ليل شعري البهيم، لمستها بأناملي وأنا أخاطبها بمرارة:
-اطمئني، النصر لكِ في النهاية!
غادرت حجرتي؛ ليستقبلني ابني ذو الثماني سنوات ببشاشة تنير ظلمة نفسي:
-ماما، صباح الخير .
– صباح الخير يا عُمري.
أقولها له مبتسمة، وأنا أتلقفه في حضني،
وأضم جسده الهزيل بقوة، وكأنني أحتضن نفسي، وعمري الذي تسرب من بين أصابعي دون أن أشعر، مؤكدة لها أنه لم يضع هدراً.
-ماما، أنتِ تخنقينني!
أسرعت بأطلاق سراحه من بين ذراعيّ، منزعجة من الفكرة .
-ماما، لا تنسي تمرين كرة القدم اليوم، المدرب لا يحب المتأخرين، لابد من وجودنا قبل الميعاد بعشر دقائق.
– لا تقلق، لن نتأخر بإذن الله .
قلتها له وأنا أطبع قبلة دافئة على وجنته، وأنهض متجهة نحو الحمام؛ لأجد ابنتي تخرج منه متبخترة بخيلاء الشباب وبهائه، تهمس وكأنها تغرد :
– صباح الخير يا ماما.
– صباح الخير يا عُمري.
طَبعت قبلة خاطفة على وجنتي، ثم أخذت تقول مبتعدة عني، وهي بطريقها إلى حجرتها:
-سأخرج اليوم مع صديقاتي للتسوّق بعد العصر.
-وهل استأذنتِ والدك؟
– نعم، وقد وافق.
قالتها بصوت عال؛ لتبلغ مسامعي وهي تغلق الباب خلفها .
بقيت برهة واقفة أمام الحمام، أحملق في باب حجرتها المغلق، أرى خلفه بعين خيالي، شبابها الغض الذي يذكرني بشبابي!
كنت في سنها أرفل في أحلامي العريضة، متصوّرة الدنيا ملك بناني أعمل بها ما يحلو لي، ولم يكن يحلو لي سوى أن أكتب، أَسطر كلمات تبني عوالم هي من وحي خيالي، أنفخ فيها من روحي؛ لتستقم نابضة بالحياة، تسعدني، وتشعرني بذاتي.
لقد كان حلمي أن أصير كاتبة، حلماً سعيت وراءه بجِد وجدية بين قصور الثقافة، وبيوت الشباب، متطلعة بحياء إلى أروقة دور النشر، حتى بلغت سن الزواج لأصطدم بأمي :
– تسعين خلف سراب! البنت ليس لها سوى بيتها وزوجها!
بينما والدي ينظر لي بإشفاق وعطف
وهو يقول:
– أخشى عليكِ من لقب عانس الذي لا يرحم. أخشى أن يسرق حلمك عمرك منكِ! وقصصك تستطيعين حياكتها هنا أو في بيت زوجك!
ولا أنكر أنه عندما رأيت زوجي لأول مرة، شعرت بأنوثتي تنجذب لفحولته بقوة كانت كافية لدك كل حصوني؛ فتزوجت.
كنت في المطبخ، عندما سمعت باب الشقة يفتح ويغلق، خرجت لأنظر منَ؛ فوجدته زوجي .
-أين كنت؟!، استيقظت ولم أجدك في المنزل؟
– كنت أضبط وضعية”طبق الدش”، و أطمئن علي جودة أسلاكه على سطح البناية .
– طبعا، فالدوري على الأبواب.
-واليوم بعد عودتي من العمل، لي جولة بحث مع “الرسيفر”؛ للتأكد من تواجد جميع القنوات الرياضية، وبهذا أكون أنهيت استعدادي للحدث الأهم!
– مبارك، وبالتوفيق!
قلتها ساخرة، وأنا أوليه ظهري متجهة للمطبخ؛ لأكمل ما بدأته، بينما يتجه هو لغرفتنا مسرعاً، وقبل أن يبلغها كان يسألني بصوت مرتفع :
-أين قميصي الأبيض؟
-مكوي، ومعلق أمامك على الشماعة، كذلك بنطالك الأسود.
وصمتُ برهة؛ لأضيف مسرعة قبل أن يسأل:
-وكل جواربك في درج الجوارب “بالجزامة.”
لا أعرف لماذا أصبحت تلك التفاصيل الصغيرة تثير غيظي، والسؤال عنها يثير حنقي أكثر وأكثر ؟!
ربما لأني أدركت أن الزواج كبحر من الرمال المتحركة، ما إن تضع قدميك فيه حتى تجد نفسك تغرق ببطء في كم هائل من التفاصيل الصغيرة التي تصبح مسؤولا عنها، بينما تجرفك تلك التفاصيل بتمكّن وحذق بعيداً عن أحلامك وأهدافك.
ففي بداية الزواج، تجد عدم الاستقرار المادي، و” بُعبع” كل حديثي الزواج؛ الأقساط.
وبعد مرور أقل من عام، يضاف إليه هاجس تأخر الإنجاب، والأسباب التي قد تكون وراء ذلك، فتلهث خلف الظنون، والوساوس التي يساهم فيها المحيطين بك بشكل كبير، كل هذا يحدث إن لم تظهر بوادر الحمل في أسرع وقت!
وعندما يأتي الطفل تنقلب حياتك رأسا على عقب، ويصبح هو محورها، تنام عندما ينام، وتستيقظ عندما يستيقظ، تلهث خلفه في كل ثانية، التطعيم، التسنين، إنه دافيء ويتقيأ، عنده إمساك، لا بل إسهال، لقد تأخر في الكلام، لا بل في المشي…
وهكذا حتى تجن، وما تكاد تنتهي من تلك المرحلة التي هي أشبه بالدوامة، وتأتي مرحلة الدخول إلى المدرسة، حتى تجد من يسألك ذاك السؤال اللزج:
– ألم يحن الوقت لمُأخاته؟!
انتبهت من خواطري على صوت جرس الباب لأجد زوجي يهرع خارج غرفتنا وقد أنهى ارتداء ملابسه، يقول بنفس الصوت المرتفع:
-أنا سأفتح.
أسرعت في الانتهاء من أعداد الفطور ووضعه على الطاولة في غرفة الطعام،
لحظات سمعت بعدها صوت الباب يغلق من جديد، لأجد زوجي منتصبا أمامي متجهم الوجه، ملوحا بورقة صغيرة يمسكها بيده.
نظرت له بهدوء بينما الكلام يندفع من فمه بعصبية:
– إنها ابنة البواب، جاءت لتعطينا فاتورة الكهرباء .
– جيد !
أجبته بهدوء أقرب للبرود ثم أردفت بنفس الهدوء:
-يبدو أن محصل الكهرباء جاء البارحة، ونحن عند والدتي.
-أنظري إلى مبلغ الفاتورة يا هانم.
– تعلم أن أسعار جميع الخدمات قد زادت.
– بل السبب هو استعمالكم المفرط للمكيّف.
-أنت من يصر على تشغيل المكيّف عند النوم !
-أنا أقوم بضبط التايمر ليتوقف بعد ساعة .
– وكذلك يفعل أولادك من بعدك على التوالي!
ينظر لي شذرا ويهم بفتح فمه ليرغي ويزبد ويهدد ويتوعد، إلا إنني ابتدره بنفس الهدوء:
– لا تقلق، لقد أخذت في الحسبان زيادة الفواتير بالذات الكهرباء منذ بداية أشهر الصيف، و الآن أجلس وتناول أفطارك حتى لا تتأخر على عملك؛ فنحن بحاجة لحوافزك وعلاوتك.
ذيلت كلامي بابتسامة بينما كان هو يجلس للطاولة كطفل استطاعت أمه احتواء غضبه، والتهدئة من ثائرته بقطعة حلوى!
لا أعرف كيف للرجل الشرقي أن يكبر ويصير مستقلا بحياته؛ يشق طريقه فيها، يتزوج ويكون أسرة ويفتح بيتا، ويظل مع كل هذا طفلا في جسد رجل؟!
وهل هذه الخاصية تخص الرجل الشرقي فقط أم إنها في عموم الرجال؟!
قبل أن يخرج زوجي متوجها إلى عمله،
سألني سؤاله المعتاد:
– هل تريدين شيئا أحضره معي عند عودتي؟
– سلامتك.
– ألا ينقص البيت شيئا؟!
– ما ينقصه سأشتريه أنا؛ ينجح البائعون دوما بخداعك إما في الجودة وإما في السعر .
ينظر لي مغتاظا، ثم يقول لي محاولا كظم غيظه، معترفا في قرارة نفسه بصحة قولي:
– هكذا إذن، فليكن! أراكِ على الغداء.
انبثقت من فمي ضحكة، بينما هو يخرج ويغلق الباب خلفه، أشعر بسعادة طفولية عندما أنجح في إثارة غيظه!
أحضرت مفكرتي الصغيرة وقلمي، جلست بغرفة المعيشة مع كوب النسكافيه، أخط على أحدى صفحاتها البيضاء عنوان توسط مقدمة الصفحة:
” ميزانية الشهر”
وما إن انتهيت من كتابة العنوان، إذ بضحكات تجلجل في أرجاء نفسي، تزلزل صمتها وخنوعها، تلفت حولي فزعة؛ لأجدها تقف في أحد الأركان متّكأة بظهرها على الحائط، عاقدة ذراعيها أمام صدرها، تنظر لي باستهزاء وبقايا ضحكتها الساخرة تتساقط من بين شفتيها، إنها أنا منذ خمسة عشر عاما :
– إذن هذا ما تجيدين كتابته الآن، ويا ترى ما نوع هذا الأدب؟!
– أدب واقعي!
أجبتها متحدية، اقتربت وهي تنظر لي بحسرة وتقول:
– ألف خسارة، أين ذهبت أحلامك؟، وفيما ضيعتِ عمرك؟!!!
كان سؤالها كمشرط حاد صغير قامت بغرزه في قلبي مباشرة، لكنني أجبتها حلاوة روح:
– مازل بأمكاني الكتابة أي وقت أشاء.
– حقا!
قالتها ساخرة ثم أردفت بتحدٍ:
-هاك الأوراق والأقلام أمامك، أريني.
أمسكت بأحد الأقلام، ونظرت للأوراق البيضاء لأجد عقلي أكثر بياضا منها، وقد هجرته الأفكار مخلّفة مكانها لكل تفاصيل حياتي الصغيرة التي أعيشها لتحتلها وتملأها، عوضا عن القدرة على التعبير والسرد التي صدأت وتيبست بفعل عدم الممارسة لفترة طويلة، شعرت بالقهر وانحدرت دموعي تكتب على أوراقي البيضاء بدلا من حبر قلمي الذي يبدو أنه قد جف!
تلفت حولي بخزي باحثة عن نفسي فلم أجدها، لكني وجدت ابني ، يقف قبالتي مشدوها جزعا:
-ماما إلى من كنتِ تتحدثين؟! ولماذا تبكين؟!
أجبته بانكسار، وأنا أدرك أنه لن يفهم إجابتي:
– أتحدث إلى نفسي، وأبكي عليها!
ثم نهضت بنفس الانكسار متوجهة إلى المطبخ لأنهي أعمالي .
مع الظهيرة كنت أنهيت جميع أعمالي المنزلية، شعرت برغبة في التجول في ذكرياتي العزيزة، ذهبت إلى حجرتي، واستخرجت من خزانتي لفافة صغيرة، جلست على فراشي أهم بفتحها وأخراج ما بها، لكن وفي نفس اللحظة، سمعت صوت زوجي قادما من خارج الغرفة:
– لقد عدت يا أهل الدار، أين الغداء؟!
فعدلت عما نويت فعله، وأجلته إلى حين، دسست لفافتي أسفل الوسادة، ثم هرعت للخارج استقبل زوجي، وأعد مائدة الطعام .
بعد الغداء قررت الاختلاء بنفسي مع ذكرياتي، مطمئنة لانشغال الجميع عني،
فابنتي تستعد للخروج مع صديقاتها، وابني مع زوجي يهتمان بأمر ” الرسيفر ”
والقنوات الرياضية.
دخلت غرفتي وأغلقت بابها، سحبت لفافتي من أسفل الوسادة، وبحرص شديد فتحتها؛ لأُخرِج منها مجلة، وشهادة تقدير هي لي!
أخذت أتأمل شهادة التقدير بشجن واعتزاز، بينما عيناي تعانق حروفها بشوق وحنين :
” الكاتبة الفائزة بالمركز الأول في مجال القصة القصيرة”
لتجرفني موجة من الذكريات السعيدة بعيدا عن عالمي، ملقية بي في أحضان زمن قد ولّى، تغمرني بتفاصيل أحداثه التي مضت و اندثرت.
وبينما أنا محلّقة في سماء الماضي، هائمة مع الذكريات، إذ بطرقات على باب حجرتي جعلتني أجفل، وقد أخرجتني من حالة النشوة التي صنعتها لي ذكرياتي؛ مما سبب لي شعورا بالضيق جعلني أجيب الطارق بلهجة متذمرة:
– أدخل.
لتدخل ابنتي، وتقف أمامي متسائلة، بينما تنظر إلى الفافة التي بين يدي بشيء يسير من الفضول:
– ماما، هل رأيتِ كنزتي الزرقاء؟
– أعتقد أنها مازلت في الغسيل.
– كنتِ أود أرتداءها اليوم!
قالتها محتجّة، قلت لها وأنا أحاول جاهدة كبح جماح الضيق الذي أفرز غضبا:
– خزانتك تعج بالملابس، اذهبي وارتدي منها شيئا آخر، فالدنيا لن تتوقف إن لم ترتدي كنزتك الزرقاء هذا اليوم بالذات!
نظرت لي متبرّمة، وهي تنقل بصرها بيني وبين أوراقي، ثم ضربت بقدمها الأرض، مؤكدة اعترضها مما قلت، وأسرعت تخرج من الغرفة وهي تصفق بابها بعنف.
لم أبالي بردة فعلها غير اللائقة؛ فقد كانت رغبتي في العودة لأوراقي وذكرياتي أشد من رغبتي في الجدال معها بشأن تصرفها غير المهذب معي!
وعدت للفافتي أتناول منها المجلة وأتصفحها، حتى وصلت إلى حيث نُشِرت قصتي الفائزة؛ فأخذت أتأملها باستغراق، وإذ بالباب يُطرَق من جديد، ويدخل ابني الصغير دون أن أذن له:
– ماما .. ماما!
-نعم.
– بابا يريد أن يشرب شايا!
– حاضر، أذهب أنت وأنا سأّعد لبابا الشاي.
-ماما.. ماما!
-نعم
قلتها بنفاذ صبر،
-لا تنسي موعد تدريب الكرة.
– لن أنسى.
خاطبته بعصبية أشبه بالزجر لم يعهدها مني، فتسمر في مكانه متفاجئا، وقد اتسعت عيناه البريئة بينما يقول لي ببطء:
– ماما، هل أنتِ غاضبة مني؟!
في تلك اللحظة شعرت بكراهية شديدة تجاه نفسي؛ فما ذنب أطفالي وتلك الأحلام البائسة، سحقا لي وسحقا لكل ما عاداهم!
رميت بالمجلة بعيدا، وأسرعت أحتضن أبني، وأنا أقبله بحنو قائلة له:
– لا يا حبيبي أنا فقط متعبة قليلا.
-فلنذهب إلى طبيب.
قالها ببراءته التي تأسرني، أجبته بابتسامة :
-لا داعي، هيا نذهب لنعد لبابا الشاي.
خرجنا من الغرفة معا، لأدلف أنا إلى داخل المطبخ، بينما هرول طفلي إلى غرفة المعيشة حيث أبيه.
لحقت به بعد لحظات كنت أعددت فيها الشاي مع بعض” الكيك” المعد مسبقا.
وعندما دخلت غرفة المعيشة، فوجئت بثلاثتهم، زوجي، وابني، وابنتي، يجلسون متجاورين على المقعد الكبير، يتهامسون فيما بينهم وكأنه اجتماع مغلق، وعندما شعروا بوجودي تطلعوا الثلاثة لي دفعة واحدة، بأفواه صامتة
وعيون تشى بحدوث خطب ما!
-ما خطبكم؟!
سألت بسرعة وتوتر، وأنا أضع الشاي و”الكيك” على الطاولة الصغيرة التي أمامهم.
بينما ألتفت للتلفاز بحركة لا إرادية لأجده مغلق :
-هل تعطّل؟!
قلتها وقد اتجه بصري صوب يدي زوجي؛ متوقعة أن أجد “الريموت” بين أصابعه فألتقطه وأجد لنفسي إجابة على سؤالي، لكني فؤجت مرة أخرى؛ فهاتفي المحمول بين يديّ زوجي عوضا عن “الريموت”، نظرت له متسائلة:
-ما الأمر؟! هل حدث شيء لهاتفي؟
– اطمئني، التلفاز وهاتفك بخير.
قالها وقد ارتسمت ابتسامة هادئة على وجهه، ثم أردف:
– على عكسك أنتِ!
– أنا؟!!
-نعم، أنتِ.
قطع أبني الحوار الدائر بيني وبين زوجي، وهو يهتف بحماس:
– لقد أعد بابا لكِ صفحة على الفيس؛ لكي تكتبي بها قصصك، ويقرأها الناس.
أسرعت أخته بلكزه لكزة خفيفة، وهي تخاطبه معاتبه:
– لقد أفسدت المفاجئة.
– صفحة، أي صفحة أنا لا أفهم شيئا!
ابتسم الجميع؛ لعلمهم بجهلي المطبق بكل ما يخص الأنترنت؛ فقد كنت حتى تلك اللحظة لا أتعاطاه، ولا أتعامل معه إلا في أضيق الحدود!
جذبني زوجي من يدي لأجلس بجواره، بينما كانت ابنتي تسحب أخيها من يده صوب حجرته، وهي تقول بابتسامة واسعة:
– بابا سيشرح لكِ، بينما أساعد أنا أخي في ارتداء ملابس التدريب وإعداد حقيبته الرياضية، قبل ان أخرج لألتقي بصديقاتي .
نظرت لها باندهاش؛ فلم أعتاد منها تعاونا، او اهتماما بغير عالمها الخاص؛ كشأن أغلب المراهقين !
انتبهت على صوت زوجي يخاطبني:
– لقد أعددت لك صفحة على الفيس؛ لتنشري عليها كل ما تكتبينه من قصص؛
علّ تفاعل الناس يشجعك على العودة للكتابة، وسأدعو جميع الأصدقاء والأقارب للأعجاب بها، أظن لم يعد لديكِ أي حُجة! وسأساعدك في توفير الوقت للكتابة؛ فمثلا أنا من سيصطحب ابننا للتدريب!
ثم أردف بنبرة ممازحة:
– إلا إذا تعارض هذا مع مباريات الدوري طبعا.
أكمل كلامه بضحكة جذابة، بينما
أنظر له، وكأني أراه لأول مرة، كيوم أن جاء لمنزل أهلي للتعارف وطلب يدي!
وشعرت بعيني تغرورقان بالدموع .
نظر لي بعطف وحنان، وهو يقول:
– لم تخبريني بعد، ما الأسم الذي ستطلقينه على الصفحة؟
أجبته بدون تردد:
– سأسميها ” أين عمري؟”
نظر لي مستغربا الأسم، فأردفت موضحة:
– فهذه الصفحة ستكون الأجابة الأبدية لهذا السؤال!
لم يبدو أنه أدرك معنى لكلامي، بينما كنت أنظر بابتسامة شامتة لنفسي منذ خمسة عشر عاما، وهي تقف في أحد الأركان تذوب حرجا، وتتبدد في الهواء!
تمت