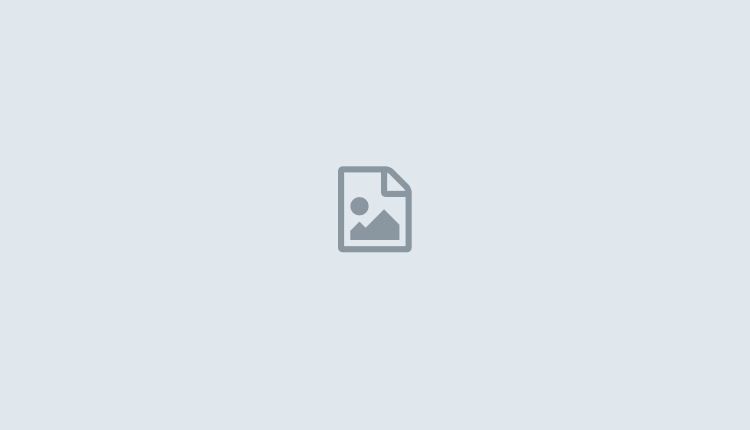بقلم / محمود أمين
تنبيه:
في مجمل هذا المقال إفادة تميل إلى التشويق كدعوة للقراءة، فلو كنت تقرأ لمجرد القراءة فارجع راشدًا فلن تجد في هذه المقالة شربة ماء، ولو كنت قارئًا تبحث عن وقود يحركك نحو كتاب تقرأه فهذه ضالتك، كما أنها ليست دراسة تحليلية تستند إلى العلم ولكنها رأي قارئ يأمل أن يكون ممن يفيد.
السنجة رواية الواقع الذي نغمض أعيننا عيله في تكبر واشمئزاز بعدم مصداقية ما رأيناه، ونعيد ترتيب الأفكار ألف مرة أن ما رأينها ما هو إلا خيالات أدبية في رأس أديب لا يجرؤ على كتابتها، وهي بدورها لا تستطيع الخروج للنور من شدة ما تلاقي من استهجان واستنكار؛ ولكنه الدكتور أحمد خالد وحده فعل.
«عفافُ» الروايةِ هي في كل مكان تقفز كطفلة وتلعب السيجة وتغني كأمها في نشوة الطرب، تنظر في كل مرآة تجدها لتتأكد من خصلاتها الجميلة كأنه إرث ملك يخاف ذهابه فهو لا يغفل عنه ولو غفل يعود لينظر إليه نظرات طويلة، هي الفتاة الجميلة التي أخذت عن أمها المسؤولية في يوم ما بالقائمة المطلوبة وترددها طيلة الطريق كي لا تنسى، هو أول اختبار لها في الحياة على إثبات مسؤولية الأنثى في قضاء حوائج المطبخ، وقد كان كل اهتمامها مركز على النصائح التي تلقتها لتوها ظانة أنها لو نست نصيحة لانقضت رحلتها بالفشل، ولا تعلم هذه الفتاة ما ينتظرها من كلاب يمدون أيديم النجسة في خسة لجسدها الضعيف الذي لا يظهر منه ظهر من بطن، هي متحفظة ومتألمة مما يحدث كأن طبيعتها وفطرتها تأكل رأسها وكرامتها، ولا حاجة للإسهاب في هذا الجانب فخيال القارئ أخصب من أن أوضح له بقية المشهد، هي الشابة الفتية الريانة الرخصة التي تتمايل من فرط الدلال كأغصان صفصافة لا تملك من فقرها إلا هذا الجسد النضر ولا تساوم عليه فهو قيمة وجودها؛ لكنها أيضا لم تفسر تلك العيون التي تعمل عمل الأيدي التي مرت بها في صغرها، لم تملك الحكمة والتوجيهات والتوعية اللازمة أنها تُنتهك بتلك النظرات، وخيال الرائي يسبح بها إلى ما دون الثياب، خيال إبليس يقف مذهولًا أمام هذه العيون المريضة.
لقد حملت الخيبة وتفطر فؤادي ألف مرة على عفاف التي تسكن كل بيت، واعتصره الهم حين فسره الدكتور أحمد خالد توفيق في هذه الرواية، ووضع أمامنا هذا المشهد عنوة وقال: انظروا ماذا يحدث في بلادنا؟ لقد تساقط ماء الوجه يا دكتور، وانجلى عن النظر ظلام ساعد المجتمع على تكديسه أمام أعين الناس، والجريمة جريمة مجتمع قبل أن تتحول إلى أفراد.
في الرواية أكثر من خيط تستطيع أن تحلب منه أكثر من رواية، وفيه الغريزة والدافع فالجوع حرك نوال إلى بيع لحمها لتشتري لحمًا تأكله، ولكن القدر يسخر منها في كل مرة تمارس فيها الرذيلة، كأنه يوقظها ففي مرة تصاب بالتسمم ومرة تركل كالكرة في حضور مجموعة من الشباب ويقذفونها خارج سيارتهم كالقمامة القذرة، ومرة ومرة… والقدر لا يكف عن الدروس للإنسان حتى يقول الإنسان: قد وعيت! قد فهمت!
وفي الرواية الجشع الذي يحرك «صلاح» إلى بيع الممنوعات والمهلوسات وفيه شهامة العرب وحرصها على نفع بعضها، فهو لا يبيع خارج «دحديرة الشناوي» -المكان الذي اختاره المؤلف كي يثبت عليه الحوادث- كما أنه يراعي السن في البيع ونوع المنتج والكمية، وينقل مصابي التناول المفرط إلى المستشفى، ويحرص على إطعامهم الطعام الجيد وشربهم كي يطرد الجسم السم الذي تناولونها أقصد الذي باعه لهم، وهو يمارس حياته كبائع للسعادة وبنى أفكاره على هذه النية، ولا يرى في نفسه أنه يدمر آلاف الناس ويلتهم حياتهم كأنه ثقب أسود، وشر الناس من بنى أفكاره على أنه بائع سعادة فهو معول هدم في أي مكان يدخله وهو نار تأكل ولا تُبقي إلا الرماد من خلفها فلو قضت الأقدار أن تقابل «صلاح» فلا تخدعنّك ابتسامته ولا تأخذ منه أي شيء ولو وقف على أم دماغه.
رأيت رجلا يحتضر يلقن أهله: لا يدخل على غُسلي فلان وفلان، وكنت أستنكر هذا منه زمنًا إلى أن قرأت الرواية فقد وجدت مصطفى المزين الرجل المسن البصباص يحب القبور وأمورها ويلحق نفسه بالمرضى ويرشدهم بدون علم ويقدم نفسه في الجنائز ويدفن كلحّاد؛ وحين سُئل عن ذلك؛ قال: إني أحب هذا وأستلذ به، كيف يحب الرجل التقدم في هذه الأمور من دون أن يبتغي مرضاة الله، ودون أن يتم استدعاءه من أهل المتوفى، لقد تعجبت كثيرًا وستتعجب معي حين تركز الضوء على مصطفى الذي لا يكف عن السباب واللعنات وتناول سيرة الناس بما يؤلمهم، وهو حلّاق لا يتقن ولا يخلص في عمله، وهو ابن ستين سنة وقدماه في القبر ويشتهي فتاة بعينها في الحي وكلما مرت لا يفوت لذة من نظر ولو كان مشغولًا بتمرير الموسيّ على رقبة زبون.
السنجة والسرنجة والسيجة والسرجة: كلمات أُحجية استطاع الدكتور أحمد أن يستخدمها بإتقان ويشوقنا إلى فهم كل واحدة، ويضع لكل واحدة الأدلة التي تثبت قوتها وأهميتها وعنما تمر بكل فصل من فصول الرواية تقول: لو سماها السيجة أو السرنجة أو كذا لصح القول، ولكنه يعود في الفصل التالي ويهدم ما بناه القارئ من تكهن ويجعله يتمسك بكلمة جديدة؛ في رأيي أن كل هذه الكلمات مترادفة فيما بينها تحمل المرارة والغصة على كل إنسانية ولد أنثى في مجتمع لا يرحم هذه الأنوثة، ولا يحملها فوق عاتقه كحياة لا تتم إلا بصون جزء منها؛ فالرجل لا تتم رجولته إلا بحفظ أنثاه، والمجتمع لا تتم فضيلته إلا بحفظ أنثاه ولو مات الناس جميعًا دفاعًا عن شرف أنثى لخلدهم الدهر بل لخدتهم البشرية وتناقل أخبارهم العالم من جيل إلى جيل، والتاريخ خير شاهد على ذلك.
لقد طرت على أحداث من الرواية وأفكار حُفرت في نفسي فأحببت أن أنقلها إلى كل محب للقراءة كي يتناول من بعدي هذه السنجة ويعطي لها حظًا من نفسه البريئة ويقدس حياة الفقراء الذين لم يرحمهم أبناء جلدتهم أنفسهم؛ فجمعوا عليهم ذل الفقر وذل النفس، وكي لا تتفاجأ بما يحدث كل يوم من انتحار، فلا أحد يحب أن يُشك بدبوس ولكنها النفس حين تضيق والحياة حين تؤلم لا تجد أمامها إلا أن تفتك بنفسها وقد صدق المؤلف حين قال: «عرفت أنها ستموت.. لن تتحمل شمس يوم آخر على جلدها».
وقد ترك الدكتور أحمد قصة واحدة مفتوحة هي قصة «عصام»، وأطلق لخيال القارئ أن يتوقع ولكنه ترك لنا توقعًا واحدًا لا نستطيع أن نفكر في نهاية سواها هو ذهابه «لحماصة» البلطجي كي يسترد شرف عفاف ونوال ومروة وصبيحة؛ ولو كانت نهاية فيلم في السنيما لتفاءلت وقلت أنه سيعود برأس «حماصة» على رأس سنجة، ولكنه سيموت كصديقه البائس «حسين».
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.
تتجه
- فوائد للثوم المشوي تساعدك على تجاوز الشتاء بسهولة
- فيتامينات لصحة العين لا يمكنك تفويتها
- فستان الزفاف الماليزي التقليدي تاريخه ورمزيته
- مرض اليد والقدم والفم عند الأطفال
- برجك اليوم 21 ديسمبر 2024
- ألمانيا: القبض على المشتبه به في الهجوم على سوق عيد الميلاد
- دراسة لا تجد أي علاقة بين تناول البيض والسمنة
- تهنئة قلبية بمناسبة عيد ميلاد الإعلامية إيناس سلامة
- “معجزة طبية: إنقاذ حياة رضيع بجراحة دقيقة في المخ بمستشفى كفر شكر”
- حق الجوار فى الإسلام
السابق بوست
القادم بوست
قد يعجبك ايضا
تعليقات