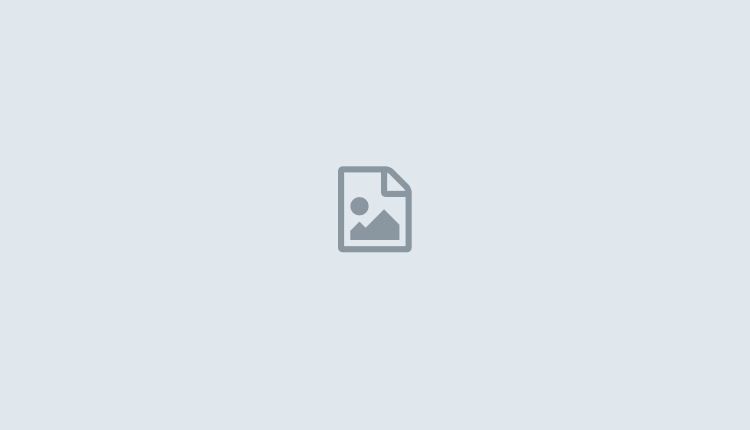بقلم/ حسن محمد
سلامٌ عليك، حبيبَنا الغائب الذي لم يرحل.. فقيدُنا الراحل الذي لم يغب، ففي غياهب الذاكرة لن ولم تطأ قدماك أبدًا أعتاب النسيان..
أمَّا بعد،
فإني سأنطقُ الألف، كما اعتدنا عند بداية قوْل السَّلام، ممدودةً بحركتين؛ مدٌّ طبيعيٌّ عند اللقاء اليومي الاعتيادي بيننا. وسأتبعها بكلمة عليكمّ «بميم مشدودة». وزدّ الحركات إن شئت تبعًا لمدة الفراق؛ بيد أن هناك علاقة طرديّة تقع بينهما.
إذا فالمعضلة لي: كيف تنطق الألف بعد غياب أربع سنوات، وكم حركة سأحتاجها لكي أمدّها؛ عشرات، مئات أم أُلوف؟!
إنني أظن لو أنك كنت تحيا بيننا؛ لضمنت إجابة عقلانيّة، مُتَّزِنة نفسيّة بصدد هذا الأمر؛ نظرًا لرجاحة عقلك وتفهُّمك للأشياء المعقدة كيف تحوّلها إلى أمور بسيطة..
الحق أني حسبتها مجرد مسألة عادية؛ حين أخبرتك أنك فارقت الحياة مذ أربع سنين، نظرًا لحسابات الدنيا للوقت والزمن المتعارف عليهما! لكن الأمر يصير مختلفًا وقتما نعيشه ونحسّه. بيد أن فكرة غياب شخص عنا، مجرد الفكرة وهو حيّ، تؤلمنا ونرفضها إلى أن يتحول الخوف -الذي نولي منه هاربين- إلى كابوس صادم يزلزل أركان القلوب، ويصعق أرجاء العقول على صحوة بعد حُلمٍ.. إلى واقع في الحقيقة هو حُلمٍ لا يقظة بعده أبدا.
ففي غياهِب الموت تمر السنون شهورًا.. وربما أيام.. وعليه قد مددت الألف حركتين، مثلما اعتدنا، كأنك حيٌّ لم تغب سوى أربع أيام فقط… أو كما قلت إن قدميك لن ولم تطأ أعتاب النسيان!
فأنا حيثما كنت أراكَ يولِّ قلبي فَرِحًا مُهلِّلًا شطر مجلسك؛ ليصافحك أولًا ثم تليها مصافحة اليدين المتعارف بهما، بيد أن سلام الأحبّة محلُّه القلب قبل الأيدي. وعليه يبدا استقبالك البهيج -بعد ردك على تحية السلام- عند قوْلك: أهلًا أهلًا أبو علي.. فتأتي القُبْلاتُ الودودةٌ لتلثِّم نَشوة الحُبِّ -قبيل الاخاديد- من شوق الغياب، ثم يتبعها عناق طويل(وشدّ ما أفقده!)؛ فينشرح الصدر ثم يطمئن القلب ويسكن.
كما أنك تفعل ما فعلته، تمدّ الألف لحظة السلام.. ثم تشدّ على لام «أهلًّا».
برغم أن ذلك مُنافٍ لنطقها وكتابتها اللُّغوية النحوية.. لكن الحق يقال: أنا الذي كان يفعل ما تفعله؛ سارٍ على نهج تحيتك. أليس المحبُّ للحبيب محبًّا في كل شيء يحبَّهُ ومقلدًا في ما يفعلهُ؟ بلى، كما أن لغز الشدّ والمدّ؛ سيَّان لتحية طيبة وعُرف الودِّ عند الأحباب الكرام.
على كُلٍّ كنت سأتشوقُ إلى سماع إجابتك عليّ، في تلك المسألة الصعبة، أقصد بقولي إني أشتاق لك كما تشتاق صحراء جرداء -تقع بالخط الإستوائي- إلى هطول الأمطار.. سريان المياه خلال أديمها الجاف المتشقق. على أن الصحراء اِشتياقها ينبع عن تجربة سابقة، وإلاّ فكيف عرفت معنى الاشتياق لرائحة المطر ونسيم الرياح؟ برغم قلّتهما، إلاّ أنها تحيا بأمل ظمآن إلى إرتواء بـ «لعلَّ الله يحدث بعد ذلك أمرًا».
وعليه فإن قلب المحب يحترق شوقًا للحبيب الغائب. إن كان حيًّا، فأن ثمة لقاء سيهدأ لوعة الشوق. أما عند غياهِبِ الموت، يكون التوهمُّ والألمُ صديقين وفيين لبعضهما، يعيشان في الظلام ويصارعان صديقي الصبر والأمل: أن هناك لقاءً آخر سيجمعنا بأحبابنا في الجنة، هذا وعد الله، ولا ريب في ذلك.
سيظل الصديقان الأولان بوجوه العابرين يبحثان دائما عن شخص يشبه الحبيب الغائب، بحثا مضنِيًا ولن يجدا مثله حتى وإن وُجِد! أو يشُمّان روحه خلال عطر مرور أحد الكرام.. وهل لغير الكرام من الخلق سيكون شبيهكَ؟!
يا عزيزي الغائب، هل تعلم أنَّ إرتواءَ المحبِّ المتعطش عند الحبيب شَربةٌ من حديث يجريه معه، تبادل معسول الكلام وملاعق النِّكات التي تضحكهما ولا تروق للآخرين؟!
يا عمي الشهيد،
أناديك شهيدًا، فإني احتسبُّك عند الله من الشهداء. الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فكم تألمت وصبرت على مرضك! وإني لا أقل عنه كما يقول الناس: المرض اللعين.. الخبيث.. أي «الكانسر»! بيد أن ابتلاء الرحمـٰن رحمة ومغفرة.. وأؤمن أن الحبيبَّ الحقِّ -الله- كان يحبُّك؛ فأحبّ أن تلقاه نظيفًا، طهورًا.. خالٍ -إن شاء الله- من الذنوب جميعها.. وشدّ ما كنت «الغالي.. الحكيم.. المرح.. الحنون..».. كما من رحمته أن جعل المرض يهوِّن ويربت على قلوب العباد.. فلا شك أن المرض يخفف من وطأة الألم عند الفراق، لأننا نرى تألم الحبيب، حينذاك يقول محبو الفقيد: الله يتولاه برحمته.. الله يخفف عنه.
لذا أحيانًا يصبح الموت -وقتما يحلّ الألم ويشتدّ ونفقد به الأمل- أُمنيةً مَرجوَّةً راحة له ولا لشاهديه أبدًا! مجرد ملعقة من دواء مسكن يهدأ من لوعة الشوق.. وجذْوة الحنين التي لا تنطفئ أبدًا..
أخيرا، عمي الحبيب، وليس آخرًا..
الحق أني في بداية الأمر كنت أخاف عليك من وحدة القبر. أما الآن فلست وحدك؛ فبجانبك يرقد عزيز آخر على قلبي، فأقرِئه مني السلام، وعلى جانبيكما الآخر ترقد عزيزتكما ومحبوبتكما.. فمني لها سلامًا خاصًّا، وقُبلةً على خديها ويديها. سأكتب لها قريبا.. كما يحزنني قول ذلك! ولكنها «دُنيا» كما كانت تقُل..
وإني في انتظار قريب ربما، أم بعيد. على موعد آخر.. بها سأحيّكم تحية كبيرة. مدادها اليابس والبحر.. المشرق والمغرب.. الشمال والجنوب.. وسوف نتسامر -لو كان هنالك في الجنة تسامرٌ- تسامرا بلا ملل ولا كلل.. ونحسو الشاي الثقيل بيد الحاج حسن «أبو ثروت»، الذي كان يأتي به اثنين؛ حيث كوب ثانٍ مع كل كوب، فيسكب بعض من الكوب الساخن الممتلئ إلى الكوب الفارغ؛ حتى يكون باردًا على ألسنتنا. شايٌّ يُسقى بيد الحنان ومذاقه من عُرف المحبّة؛ لذا كان لا يحتاج إلى السُكر. وبذلك ترددت (فأعود إليه من حين لآخر) إلى أن توقفت، لأني لم أذق مثله أبدًا!
كما سننتظرك نحن الثلاثة، يا فقيدنا الأول؛ عمي وأستاذي «ثروت».. أن تعدّ لنا أربعة من الجنزبيل تارة والقرفة تارة.. فنشربهما بأُذن رامية صاغية محبّة لقولك الراشد: إن بهما من فوائد جمّة ستعود علينا بالنفع..
مع صعود روح المحبوب إلى الحبيب الحقِّ؛ تخبو شمسُ الحياة.. تُكتسى السماءُ بلونٍ مُكْفهِرٍّ كالحٍ، فتلتمع ببكاء عيون المحبين.. تحلُّ الصدمةُ محلَّ صعقة البرق؛ فتهتز أرجاءُ القلوب، وترتعش الأبدانُ الوانية.. حيث يكون هزيمُ الرّعد المدويّ على مسمع الجميع؛ صوتَ انتحابهم وصرخاتهم…
تتوارى القلوبُ المشرقةُ وتغيبُ خلف سِّتارة الوداع الأخير مع سِّرْب الحمام الطوّاف الهادل دائما بالأمل.. فبعد هزة القلوب يسقط جريحًا.. إما أن يفقد القدرة الكلية على التحليق في السماء، أو يتظاهر دائما بالتحليق الكاذب بجناحيه المكسورة.

رئيس مجلس إدارة جريدة القاهرية