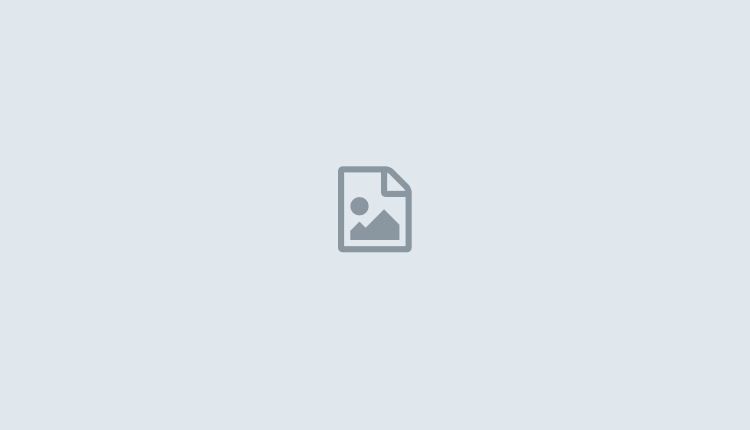إعداد / محمـــد الدكــــرورى
ونكمل الجزء الرابع عشر مع فضل الحديث، وقد توقفنا عند خلو الحديث من التفسير الفلسفي الذي يخالف المألوف من بيانه صلى الله عليه وسلم وخلوه من الأساليب الفقهية التي تتعرض لذكر الشروط والأركان، وما إلى ذلك مما لم يكن معروفا في عصر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وانطباق الحديث على الواقع، وعدم وجود باعث سياسي أو نفسي دعا إلى وضعه، وذلك ما ضمنه الناقد نقده، ولو تهيأ له أن يكون واسع الاطلاع دقيق النظر، لتبين له أن كل ما ذكره من ذلك تتضمنه تلك القواعد السابقة، ولم يفت رجال الحديث مراعاته في نقد المتن، فقد ردوا حديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم الحمام بناء على أن النبي صلى الله عليه سلم لم يدخل حمّاما قط، وأن الحمامات لم تكن معروفة في الحجاز على عهده صلى الله عليه وسلم وكذلك ردوا حديث وضع الجزية عن أهل خيبر، بناء على أنه مخالف لما علم تاريخيا من أن شرعية الجزية لم تشرع إلا بعد فتح خيبر، وردوا بعض الأحاديث لمخالفتها للواقع، وذلك كحديث ” لا يولد بعد المائة مولود لله فيه حاجة” وحديث ” الباذنجان شفاء من كل داء” وردوا ما رواه غلاة الشيعة من أحاديث في فضل الإمام علي بن أبى طالب، وما رواه غلاة البكرية من أحاديث في فضل أبي بكر الصديق، لوجود الباعث السياسي على وضعها، وردوا كذلك حديث ” رمدت فشكوت إلى جبريل فقال أدم النظر في المصحف.
لأنه لا يتفق مع البيئة التي قيل فيها، إذ لم يكن على عهده صلى الله عليه وسلم مصاحف، وكذلك ردوا أحاديث أخرى لوجود الباعث النفسي على وضعها كحديث ” الهريسة تشد الظهر” ذلك لأن راويه كان ممن يصنع الهريسة، وردوا كذلك كثيرا من الأحاديث، لما فيها من عبارات واصطلاحات فقهية لم تكن معروفة على عهده صلى الله عليه وسلم والأمثلة من ذلك كثيرة قد أشير إليها في كتاب “نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية” للزّيلعيّ، وهكذا يرى أن كل ما زعم الناقدون استدراكه على علماء الحديث لم يغفلوه، بل راعوه وذهبوا إلى أبعد منه، غير أنه قد يلاحظ في هذه الضوابط وفي تطبيقها الأمور الآتية، أن كثيرا منها يقوم على تقدير الباحث وفهمه ونظره، وأنظار الناس متفاوتة، ومواهبهم مختلفة، وأحكامهم متباينة، وما لا يعقله فلان يعقله فلان آخر، ولهذا كانت أحكامهم على الأمور مختلفة، أو على ذلك كان تطبيق هذه الضوابط على الأحاديث مختلف النتائج باختلاف أنظار من يقوم بتطبيقها، فركاكة المعنى في كثير من أحوالها مما يختلف فيه أنظار الباحثين يراها هذا في معنى من المعاني، بينما لا يراها الآخر فيه، وكذلك الحال في مخالفة الحديث لما تقضي به قواعد العلم أو تجارب الطب، بينما يراها شخص في حديث لا يراها الآخر فيه، أو مخالفته لما يقضي به العقل، فإن عقول الناس تختلف اختلافا بينا يستسيغ بعضها ما لا يستسيغه بعضها الآخر.
ويجوز بعضها ما لا يجوزه بعضها الآخر، ويستبعد بعضها ما لا يستبعده بعضها الآخر، فبأي عقل يوزن الحديث؟ وأنى لعقل أن تكون له قوة وحكم عند صحة السند، والظن بصحة نسبته، وكذلك صدور الحديث مِن راوى تأييدا لرأيه المتعصب له المغالي فيه مما تختلف فيه الأنظار، وهذا ما يكشف عما في تطبيق هذه القواعد والضوابط من عيب ونقص، يؤديان في كثير من الأحوال إلى خلاف واضطراب، وأيضا أن استعمال هذه المقاييس والضوابط مشروط بألا يكون في تأويل الحديث تأويل سليم سائغ يحتمله، أو لا يكون في حمله على المجاز مخرج مِن تطبيقها، وبناء على ذلك إذا احتمل الحديث تأويلا يخرجه عن محيط ما تتناوله هذه القواعد لم يجز أن تطبق عليه، وكذلك إذا كان حمله على الاستعمال المجازي يبتعد به عن هذه الضوابط لم يجز أن تتناوله، وتأويل الحديث وقبوله للتأويل وجواز إرادة معنى مجازي منه مما يختلف فيه الناس، فيكون مقبولا سائغا عند شخص، وغير مقبول عند آخر، وعلى ذلك يختلف الحكم على الحديث باختلاف الناس واختلاف أنظارهم، وأن تطبيق هذه القواعد يقوم على فهم الحديث فهما معينا يجعله من متناولها، وهذا مما يختلف فيه الناس أيضا، وتتفاوت فيه أنظارهم فقد يفهمه شخص فهما سليما غير مناقض للمعقول ولا للأصول المسلم بِها، ويفهمه آخر على غير هذا الوضع فيراه مخالفا للمعقول أو لما تقضي به الأصول.
وأن الحديث إذا كان سليم السند يرويه الثقة عن الثقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أمرا راجحا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كسائر الناس في علمه، وحكمته، وصلته بربه، ومعارفه، وذلك مما يستوجب ألا تكون مقاييس النقد فيما يصدر عنه مماثلة لمقاييس النقد في أحاديث غيره من الناس، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي عن ربه، وقد أطلعه الله سبحانه وتعالى، على كثير من أسرار الغيب، مما لم يطلع عليه سواه، وأحاط بما لم يحط به إنسان من المعارف والأسرار، وذلك ما يقضي بأن يكون تفكيره فوق تفكير غيره من الناس، وبأن يعلو حكمه أحكام غيره من الناس، فيصدر منه من الأقوال والأحكام ما قد يعلو على أفهام الناس، وما لا تصل إلى معرفة كنهه وحقيقته عقولهم في عصر من الأعصر، وما قد ينكشف سره بعد ذلك، وعلى ذلك فلا ينبغي أن يكون لهم مع قصور عقولهم سلطة الحكم على أقواله من ناحية سلامتها وصحتها، مما قد تعجز عقولهم عن فهمه ولا يصح أن يكون عدم فهمهم لقصر عقولهم، أو لضعف معارفهم دليلا على وضع الحديث، وبناء على ذلك إذا جاء الحديث متضمنا خواص بعض النبات مما لم يكشفه العلم، أو خبرا عن غيب سيقع في مستقبل الزمن، وما إلى ذلك مما لم يصل إليه علم الناس، فلا يجوز أن يتخذ ذلك دليلا على وضع الحديث.
وإن لهذه الأسباب كان تطبيق علماء الحديث لهذه القواعد في نطاق ضيق، حيث تكون الضرورة قاضية بتطبيقها، وذلك عند تعذر التأويل الذي يمكن اتخاذه مخرجا، وعدم الوصول فيه إلى مخرج آخر يستساغ معه عدم التطبيق، وقد كان صنيعهم في هذا خاضعا كذلك لتقديرهم وأحكامهم، ومراعى فيه كذلك الاعتماد على صحة السند وسلامته، وما لذلك من أثر في اطمئنانهم إلى نسبة الحديث الشريف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومع هذا الاطمئنان يجب التسليم وانتفاء كل شك، وهذا لشعورهم حينئذ بقصور عقولهم، وقلة معرفتهم وعلومهم، لهذا كله كان تطبيقهم لهذه القواعد في حدود ضيقة كما قلنا، وكان مع ذلك محل خلاف بينهم تبعا لاختلاف أنظارهم، فاختلفت أحكامهم على بعض الأحاديث فكان ما يراه بعض العلماء صحيحا ويراه آخرون غير صحيح، وكان من نتيجة ذلك وجود بعض أحاديث كان وجودها في الصحاح مبعث النقد الذي أشرنا إليه، ومما يجب ملاحظته أن هذا النقد لا يعدو أن يكون طعنا في أحاديث معينة معدودة أثبت الاستقراء أنها ليست في أصول الدين، ولا في قواعده وأحكامه الأساسية، ولا يعد عدم الاعتماد عليها أو تركها ما يتنافى مع وجوب العمل بالسنة الآحادية، لأن وجوب العمل بها كما بينا إنما يكون عند غلبة الظن بصحة نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عند الشك في نسبتها.
وما وضعه علماء الحديث من قواعد وضوابط لنقد السند والمتن كفيل عند تطبيقه تطبيقا سليما بتمييز صحيح السنة من غيره، وتمحيص السنة من جميع الأحاديث الموضوعة بالقدر الممكن، وعند ذلك يتميز ما ترجح الظن بصحة نسبته مما شك في صحة نسبته، وإذا ما تبين ذلك وجب العمل للقطع بوجوب العمل عند الظن، وعلى ذلك فلا يعد هذا النقد طعنا في السنة ولا في وجوب العمل بها عند سلامة السند والمتن، إذ عند ذلك يكون الظن بصحة نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا راجحا يوجب العمل بها، وأما عن وجه إلى حجيتها من شبهات، فقد أشرنا فيما سبق إلى ما جاء في الكتاب العزيز من الآيات الدالة على أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة في كل ما أمر به، وفي كل ما نهى عنه، وإلى أن دلالة هذه الآيات باجتماعها وأساليبها دلالة قاطعة، لا تقوم معها أية شبهة في وجوب هذه الطاعة، ولا في حجية هذه السنة فيما جاءت به من أحكام، وأن إنكار ذلك إنكار وتكذيب لما جاء به القرآن الكريم وأكده ووثقه، ولكن بعض الناس ممن خدعهم زيف المستشرقين والمبشرين قامت في أنفسهم آراء منحرفة بسبب ما تلقوه من هؤلاء من شبهات صدتهم عن الحق، وأعمتهم عن النور، فمنهم من ذهب إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يتعبد الناس إلا بما شرعه القرآن، فهو وحده واجب الطاعة، وليست السنة إلا بيانا له وتطبيقا مؤقتا في أحكام المعاملات.
وقد روعي فيه ما كان لزمن صدورها من عادات وأعراف ومعاملات، وما كان لأهله من علم ومعرفة وإمكانيات وتقاليد، ولذلك لم يكن للطاعة الواجبة صفة الدوام والاستمرار في هذا النطاق، وإنما كانت موقوتة بعصرها، حتى إذا تغير العصر بعاداته وأعرافه تغير التطبيق، لما جاء من عموم في الكتاب خاصا بالمعاملات، ولم يكن ما ورد من السنة في ذلك واجب الطاعة، وعلى هذا الأساس وجدت جماعة في الهند تسمت بجماعة القرآن، أو بأهل القرآن، لا تعمل إلا به على النحو الذي يهديها فهمها إياه، وكذلك وجد في الناس من طعن في حجية السنة، ومثلهم وجد قديما فماتت مزاعمهم بانقضاء زمنهم، ولكن من يوجد الآن يتمسك في عدم الاحتجاج بالسنة بمزاعم ليس لها أساس ولا حقيقة، ولا قيام لها على واقع إلا ما زوروه من خيال، فطعنوا في روايتها وطريقة نقلها، وكان ذلك على غير هدى، قالوا كيف تكون السنة حجة على الناس تلزمهم أن يعملوا بها، مع ما نراه فيه من خلاف، واضطراب، وتناقض في مروياتها، وما نشاهده فيها من زيادات في بعضها، ونقص في بعضها الآخر، وما هو معلوم مما أضيف إليها، وأدخل عليها من موضوعات كثيرة تفوقها عددا، اختلطت بها ولم يتيسر تخليصها من كثير منها، وهذا مع ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن كتابتها، ومحو ما كتب منها في عهده، ثم عدم الميل إلى كتابتها بعد وفاته.