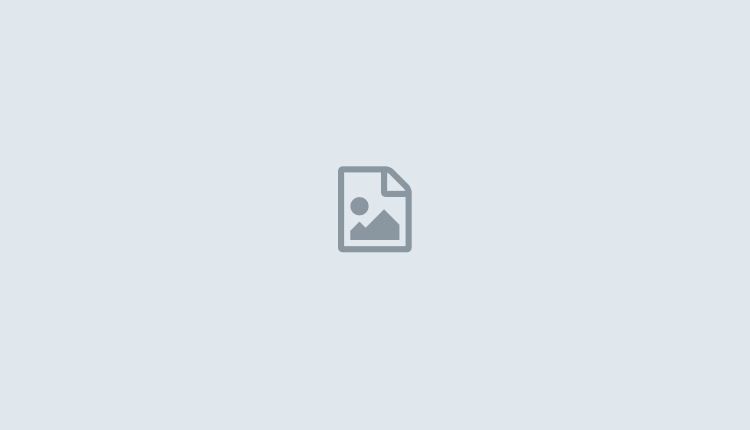كتب/ حمادة توفيق
الذي حدث كان صادماً بكلِّ المقاييس، صادماً إلى الحدِّ الذي جعلني أكلمُ نفسي أياماً طوالاً كمخبولٍ طارَ صوابه، أذكرُ تفاصيلَ ما جرى كأنه كان بالأمس القريب رغم مرورِ سنواتٍ خمسٍ عليه.
كنتُ كعادتي كلَّ يومٍ – وكأيِّ يومٍ أذهبُ فيه إلى عملي كمعلمٍ للغةِ الإنجليزيةِ – قد دفعتُ الأجرةَ لسائق السيارة، وترجلتُ منها، ثم ثويتُ في مكاني منتظراً المعدية، حيث كنتُ ولا زلتُ أعملُ في بلدٍ ناءٍ جاءَ تعييني فيه من سنوات، ثم تعذرَ نقلي إلى مكانٍ قريبٍ للمكانِ الذي أقطنُ فيه لأسبابٍ كثيرة، يسردها على مسامعي موجهُ المادةِ كلما فاتحته في موضوعِ نقلي، متعللاً بها ومبرراً عدمَ سعيه لتلبيةِ رغبتي.
يومها رستْ المعديةُ على الجرفِ، وهرعتُ بين آخرينَ في محاولةٍ للوصولِ إلى الجانبِ الآخرِ من البلدة، حتى إذا توسطتْ المعديةُ البحرَ سمعنا صراخاً من الناحيةِ التي نتوجهُ إليها وجلبةً تصمُّ الآذان، ورأينا رجالاً ونساءً يتوافدون إلى المكانِ ذرافاتٍ ووحداناً، فإذا استقر بهم المقامُ تفرقوا ينظرون داخل البحر كمن يبحث عن شيء ضائع.
عند ذلك قتلني الفضولُ، فطفقتُ أسألُ من كنتُ معهم عما يجري، لكن لم يجبني أحدٌ.
وسرعانَ ما رستْ المعديةُ فدلفتُ بين جموعِ الواقفينَ والدهشةُ تعقدُ لساني وتعتلي وجهي، ثم سرعانَ ما استحالتْ دهشتي إلى صدمةٍ هزتني هزَّاً، فلقد سمعتُ بعضَ الواقفينَ يصرحُ بأنّ الأستاذَ محمد عبدالسلام ألقى بابنته في البحر.
ياللوجع! ابنته؟ مهلاً، أليست هي ذات الابنة التي وهبه اللهُ إياها بعد سنواتٍ خمسٍ من عدمِ الإنجاب؟ فكيف طابت نفسه أن يلقيها في البحر إذن؟ أمخبولٌ هو؟ مهلاً، فمحمد مدرسٌ ذكيٌّ حصيفٌ وذو خلقٍ قويم، هو مدرسُ الفلسفةِ في المدرسة، أيُعقلُ أن تكونَ الفلسفةُ قد أثرتْ على قواهُ العقليةِ؟ أسئلةٌ جمةٌ طفقت تصولُ وتجولُ داخلي، واستحالتْ إلى دهشةٍ ممزوجةٍ بحيرةٍ ألفيتُ نفسي بين براثنها لدقائقٍ ثقال.
ثم خطرَ لي أن أتجولَ بين الواقفينَ على الجرفِ لأسترقَ السمعَ وأستشفَّ ما جرى.
قالوا أنه كان ثملاً يومها ولم يكن في كاملِ وعيه، فتصورَ أنه يحميها من بطشِ الأيامِ الصعبةِ ومن ريبِ المنون.
وقالوا أنّ تعمقه في الفلسفةِ أفقده رشده وأذهبَ صوابه وأثرَ على قواه العقلية، ولن يُسجنَ يوماً واحداً كعقابٍ على جريمتهِ الشنعاءِ في حقِّ الطفلة.
وقالوا أنّ خلافاً دبَّ بينه وبين زوجته قبلها بساعاتٍ فتخلصَ من الطفلةِ انتقاماً من زوجته.
وقالوا أنّ نزعةَ الجاهليةِ الأولى راودتْ نفسهُ الضعيفةَ، فبدلاً من وأدها في الترابِ حفاظاً على شرفه، ألقى بها في عبابِ البحرِ ولجتهِ فأنهى بيده حياتها.
وقالوا لعلَّ الطفلةَ أصابها مرضٌ عُضالٌ فلم يحتمل عذابها وهي تئنُّ بينَ يديه، فألقاها في البحر ليرحمها من عنائها المتصلِ وبكائها المستمرّ.
أقاويلٌ عدةٌ وتفسيراتٌ شتَّى، ولم أزد إلا حيرةً ودهشةً واضطراباً، وصرتُ أكابدُ مرارةَ انقباضٍ داهمَ قلبي فلم أجد له تفسيراً.
ثم آليتُ على نفسي لأنصرفنَّ من المكانِ كله، ولأختلفنّ إلى المدرسةِ لعلي أعرفَ هناك الخبرَ اليقين.
فمضيتُ إلى المدرسةِ أكلمُ نفسي كمن جّنَّ أو طاشَ عقله، وما أن دخلتُ حتى وجدتُ الشرطةَ بالداخلِ يسألونَ عن الجاني وعن الأماكن التي يرتادها أو يترددُ عليها، وعرفتُ أنه فعلَ فعلتهُ ثم لاذ بالفرارِ، وأنّ زوجته هي التي أبلغتْ الشرطة.
وسمعتُ المديرَ يخبرهم أنّ الأماكنَ التي كان يترددُ عليها محدودةٌ للغايةِ، فهي لا تتعدى المدرسةَ أو المقهى الكائنَ على أول البلدةِ أو منزله، لكنّ رجالَ الشرطة كانوا قد بحثوا عنه في ذاتِ الأماكنِ المذكورةِ فلم يجدوا له أثراً.
عندها خطرَ لي خاطرٌ أوحى إليَّ بالمكانِ الذي يمكنُ أن يكونَ قد لجأ إليه، إنها البيارةُ التي توجدُ في أقصى البحرِ على بعدِ كيلومترٍ من هنا، وهي المكانُ الذي تطفو فيه جثثُ الغرقى الذين يموتونَ في البحرِ، ولعله ذهبَ هناك منتظراً خروجَ الجثمانِ، ليلقي على ابنته النظرةَ الأخيرةَ، وليدفنها مثلما يليق بصغيرةٍ من صلبه.
فمضيتُ والساعةُ تدقُّ السابعةَ والنصفَ صباحاً، ولم أجد – والوقت مبكرٌ هكذا – أيَّ سيارةٍ لأركبها، فآثرتُ المشيَ على الأقدامِ، وما أن بلغتُ المكانَ حتى لاحَ هو من بعيدٍ في هيئةٍ مثيرةٍ للشفقةِ، فناديتُ عليه فالتفتَ وعيناه تنهملانِ بالدموعِ، فلما عرفني استدارَ ينظرُ إلى ماءِ البحرِ وهو يعلو وهبط.
دنوتُ منه وجلستُ إلى جواره، فنظرَ إليَّ وقال:
– طلبتها أمي فلم أبخل بها عليها.
عندها دقَّ قلبي فزعاً وهلعاً، وساورتني شكوكٌ في قواه العقليةِ فأحاطت بي إحاطةَ السوارِ بالمعصمِ.
– أمك ماتت من سنوات.
– أمي لم تمت، وما ينبغي لها أن تموت.
– كلنا سنموتُ يا صديقي.
وقفَ فجأةً وقد تغيرَ وجهه، ثم نظرَ ملياً إلى البحرِ، وهتف:
– رحمة!
إنها صغيرته، لعلّ البحرَ أتى بها إلى هنا، حيث يُودِّعُ الأحبةُ موتاهم الغرقى الوداعَ الأخير.
نزلَ من على الجرفِ فشمرَ عن ساعدين مفتولينِ ثم خاضَ لجةَ البحرِ أمتاراً حتى بلغَ الماءُ نِصفَهُ، ورأيته يمدُّ يديه ناحيةً ثم يلتقفُ شيئاً لم أحدد معالمه، ثم جاءَ مهرولاً، والشيءُ بين يديه، ياللهول! إنها ابنته.
وضعها بين يديَّ ثم جلسَ يلثمُ جبينها والدموعُ تنهمل من عينيه كنهرٍ جارفٍ.
– سامحيني يا صغيرتي، لم تكن ثمةَ طريقةٌ لوصولكِ هناك إلا تلك، فسامحيني.
ثم التقطها ولثمَ خديها حتى سالتْ عبراته على وجهها الأسيلِ الملائكيُّ الذي تعتليه صفرةُ الموتِ وسكونه، ومدَّ راحتيه فناولني إياها مردفاً:
– ادفنها أنت فلا طاقةَ لي لفعلِ ذلك.
نظرتُ إليه باكياً، ثم قلتُ:
– لنرجع بها أولاً ثم نفعل ما يتوجب أن نفعله.
فنهرني قائلاً:
– اذهبْ أرجوكَ لا تضيّع الوقت.
استدرتُ والطفلةُ بين يديَّ فلم أبعد سوى خطواتٍ معدوداتٍ، ثم خطرَ لي أن ألتفتَ، فإذا الذهولُ يستولي عليَّ ويتمكنُ مني أيما تمكنٍ.
لقد خاضَ محمدُ البحرَ حتى بلغ ترقوته، لقد غطاه الماءُ تماماً.
– محمد!
لم يستجب، صحت بأعلى صوتي:
– غريق!
لكن الوقت كان مبكراً جداً، وفرصةُ نجاته لم تكن سهلةً، لم تكنْ سهلةً على الإطلاق.