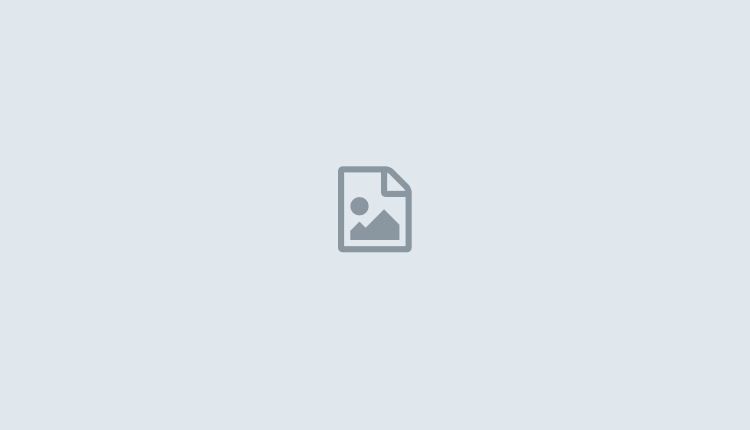بقلم / محمـــد الدكـــرورى
إن الحياة من المنظور الإسلامي هى القنطرة للدار الآخرة، وهى الوسيلة للغاية النبيلة، فبناء على التصور الإسلامي، فإن الحياة فانية، وعمر الإنسان مهما طال فهو قصير، ولقد كانت الآداب والقيم، هما السمة البارزة في سيرة الرعيل الأول من سلف هذه الأمة، فقد أولوها اهتمامهم قولا وعملا وسلوكا وتصرّفا، بل كان النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، يهذب الجيل إذا ما وقعوا فيما يناقض الذوق والأدب، ويقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما “كان الناس يتعلمون الأدب قبل العلم” وقال عبد الله بن المبارك “نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم” فكان هذا دأبهم وديدنهم، لذا حازوا الأدب العالى والذوق الرفيع والعلم الوفير، فكانوا أحسن الناس أخلاقا، وأرفعهم أذواقا، وأكثرهم ندى، وأبعدهم عن الأذى، وإن دين الإسلام الحنيف، هو دين تكافل وتراحم، وهو دين تعاطف وشفقة، وهو دين معاملة وإحسان.
وقد عمل على ذلك أولو العزائم، من السلف الكريم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدانت لهم الدنيا، وتحطمت تحت أقدامهم تيجان الجبابرة من أقاصرة وأكاسرة، وملكوا أَزمة الأمور، فكانت الشدة منهم على الكافرين، وكانت الرحمة والشفقة بينهم، مثلا للعادلين والمتأسّين، وإن الدين الإسلامى في مجموعه هو وحدة متماسكة الأطراف، محكمة العُرَى، تؤلف بين جملة من الحقوق، وإن الأخذ بها في مجموعها أمر لا مندوحة عنه، فتوحيد الله عز وجل، بأسمائه وصفاته وأفعاله، وتأليهه، وإفراده بكامل العبودية والتقديس، كل ذلك جزء من عقيدة المسلم، وفي طليعة ما يجب أن يعنى به، ولقد جاء الإسلام رسالة إنسانية عالمية لكل الناس، وليس للعرب وحدهم، ومع أنهم طليعة الدعوة، بل هم فيه سواء مع كل الناس، وقد تحدّد مكانتهم بالتقوى، وما يبذلونه في سبيل هذا الدين الذي شرّفهم الله تعالى به.
ولقد عُني الإسلام بالأخلاق منذ بزوغ فجره وإشراقة شمسه، فالقرآن الكريم في عهديه المكي والمدني على السواء اعتنى اعتناء كامل بجانب الأخلاق، مما جعلها تتبوأ مكانة رفيعة بين تعاليمه وتشريعاته، حتى إن المتأمل في القرآن الكريم يستطيع وصفه بأنه كتاب خلق عظيم، وأن الأخلاق جزء وثيق من الإيمان والاعتقاد، فإتمام الأخلاق وصلاحها من أهم مقاصد بعثة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ” لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر فقال له “يا أبا ذر، ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر، وأثقل في الميزان من غيرها؟ قال، بلى يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم “عليك بحسن الخلق، وطول الصمت، فو الذي نفسي بيده، ما تجمل الخلائق بمثلهما” رواه الطبراني، ولقد كانت الأخلاق في حياة المسلمين سببا رئيسا لعزتهم وقوتهم ومنعتهم وسعادتهم.
فعاشوا فيما بينهم حياة يسودها الحب والتعاون والاحترام المتبادل، فأسسوا حضارة بهرت العالم، وذلك لأن أي حضارة لا تقوم إلا على دعامتين أساسيتين، وهما علمية وأخلاقية، وأما العلمية فهى تنتج التطور والازدهار والرقي السياسي والاقتصادي والعلمي والاجتماعي، وأما الأخلاقية ينتج عنها الأمانة والإخلاص والإتقان والشعور بالمسؤولية وتقديم النفع وحب الخير، فإذا ما ذهبت هاتان الدعامتان أو إحداهما انهارت الحضارات وتفككت المجتمعات وحلّ البلاء بأهلها، وعندما جاء الإسلام، وهو خاتم كل الأديان، وآخر حلقاتها الموصولة، وكان ضروريا أن يكون عالميا، لأنه كلمة الله الخاتمة، وحجته البالغة إلى يوم القيامة، ولأن طبيعة مبادئه تتجه إلى العدل المطلق، والرحمة المطلقة، وإنقاذ الناس كل الناس، وإن من مقومات نهضة الأمم والمجتمعات، ودعائم تشييد الأمجاد والحضارات، تكمن في العناية بقضية غاية في الأهمية.
هى قضية هي أساس البناء الحضاري، ومسيرة الإصلاح الاجتماعي، إنها قضية القيم الأخلاقية، والآداب المرعية، والأذواق الراقية العلية، فالأخلاق والقيم في كل أمة هو عنوان مجدها، ورمز سعادتها، وتاج كرامتها، وشعار عزها وسيادتها، وسر نصرها وقوتها، وإن قضية القيم المزهرة، والشيم الأخّاذة المبهرة، التي أعتقت الإنسان من طيشه وغروره إلى مدارات الحق ونوره، ومن أوهاق جهله وشروره، إلى علياء ذكائه وحبوره لَهي جديرة بالتذكير والعناية، والاهتمام والرعاية، وأن الإسلام وحده إياه، لا غيره ولا سواه، هو موئل القيم والفضائل والشمائل، فكانت مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب ومعالي القيم من أسمى وأنبل ما دعا إليه الإسلام، فقد تميّز بنظام أخلاقي فريد لم ولن يصل إليه نظام بشري أبدا، وقد سبق الإسلام بذلك نُظم البشر كلها، وذلك لأن الروح الأخلاقية في هذا الدين منبثقة من جوهر العقيدة الصافية.
ولقد بلغ من عِظم ومكانة الأخلاق في الإسلام أن حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهمةَ بعثته وغايةَ دعوته في كلمة عظيمة وهى الأخلاق، وإن أزمتنا اليوم هى أزمة أخلاق، وممارستها على أرض الواقع وتعبد الله تعالى بها، فالكثير يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن الكريم ويدّعون الإسلام ويملؤون المساجد ثم يخرجون للتقاتل والتنازع والتحاسد فيما بينهم، ويقوم الكثير بالشعائر دون خشوع وتدبر، ودون استشعار لعظمة الله تعالى، فتسوء أخلاقهم وسلوكياتهم في البيت والسوق وفي الوظيفة ومع الجيران، وفى كل مكان، ويقول النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم “ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة” رواه الترمذي، وإن النسيج الاجتماعي المتراص الفريد يحتاج إلى وقفة إصلاحية، متونها صقل الأذواق وسجحُها.
والسمو بها في معارج الوعي الراشد والاستبصار الرائد، لتنعم حواسّنا بذوق رفيع، وبيئة نقية نظيفة، تبتهج النفوس بأزهارها، والأبصار باخضرارها، والاستظلال بوارف ظلالها، واستنشاق الهواء النقي في أرجائها، وتثير الأشواق والإعجاب وتزيح الونى والأوصاب، وتخلع على النفوس رونق البهاء، وعلى القيم الأسيلة روعة الطهر والثناء، بل تبعث على تمجيد الخالق الوهاب، ولن يستقيم حال الناس في مآلهم ومعادهم ما لم يلتزموا بشريعة الإسلام جملة وتفصيلا، فالتعاليم الإسلامية تؤخذ بالجملة والتفصيل، ولا تقبل التجزيء كوصفة الطبيب، فلا يعقل ولا يصح أن نأخذَ بعض الدواء وندع الآخر، فالعلاج لا يتم ولا يتحقق إلا بالالتزام الحرفي بالوصفة الطبية، فلا قيمة لعلم بلا خُلق، ولا فائدة مِن علم لا يؤطره منهج وقِيم جميلة، فالعلم إنا هو وسيلة لغاية نبيلة، أما إذا تحوّل العلم إلى فساد ودمار وخراب.
فذلك يدل دلالة قاطعة على أن العلم لم يهتد بالخُلق الفاضل، والتوجه القويم، فالعلم بلا خُلق دمار وخراب، فليس كل علم نافعا، فمنه النافع والضار، ومنه مَن غلب نفعه أو ضرره، فما أحوجنا اليوم دون غيره إلى أخلاق الإسلام فنمارسها سلوكا في الحياة في زمن طغت فيه المادة وضعفت فيه القيم وفهمت على غير مقصدها وغاياتها، وتنافس الكثير من أبناء هذه الأمة على الدنيا، ودب الصراع بينهم من أجل نعمة زائلة أو لذة عابرة أو هوى متبع، فما أحوجنا إلى أخلاق الإسلام، ونحن نرى التقاطع والتدابر والتحاسد على أبسط الأمور وأتفه الأسباب، فما أحوجنا إلى أخلاق الإسلام ونحن نرى جرأة كثير من الناس على الدماء والأموال والأعراض دون وجه، فما أحوجنا إلى أخلاق الإسلام وتوجيهاته ونحن نرى قطيعة الرحم وضعف البر والصلة وانعدام النصيحة وانتزاع الرحمة والحب والتآلف بين كثير من الأبناء والآباء والجيران.
والإخوة وبين أفراد المجتمع الواحد، فما أحوجنا إلى أخلاق الإسلام عندما نرى فى الشوارع والطرقات الكاسيات العاريات ونرى الملابس الضيقه والملابس الشفافة التى تظهر مفاتن النساء فما أحوجنا إلى أخلاق الإسلام وتوجيهاته لتستقيم أمورنا وتنصلح أحوالنا وتضبط تصرفاتنا ويحسن أسلامنا ويكتمل إيماننا، فلا ينفع إيمان أو يُقبل عمل أو ترفع عبادة بدون أخلاق تحكم السلوك وتوجه التصرفات، ولقد أخبر الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، في أحاديث كثيرة، ومفصلة، عن ملاحم وفتن آخر الزمان، والمعارك الفاصلة الكبرى التي ستكون بين يدي الساعة، فقد أخبرنا بها صلى الله عليه وسلم، حتى ينبهنا من غفلتنا، ويوقظنا من رقدتنا، ويحثنا على الاحتياط لأنفسنا، ولكي نراجع هذه النصوص الشرعيةَ فنجد السبيل للخروج مما نحن فيه من أزمات وفتن يرقق بعضها بعضا، وما تبع ذلك إلا من غربة للدين.
والبعد عن كتاب الله تعالى وسنة نبية صلى الله عليه وسلم، وكثرة البدع والمضلين، والانهماك في أمر المعاش، والإعراض عن المعاد، وإيثار العاجلة على الآجلة، ويجب علينا أن نعلم ان من أفضل الأخلاق وأجملها هو الإيثار وستر العيوب وإبداء المعروف والتبسم عند اللقاء، والإصغاء عند الحديث، والإفساح للآخرين في المجالس، ونشر السلام وإفشاؤه ومصافحة الرجال عند اللقاء والمكافأة على الإحسان بأحسن منه، وإبرار قسم المسلم والإعراض عما لا يعني وعن جهل الجاهل بحلم وحكمة، وهكذا كل تصرف طيب يجعل كبير المسلمين عندك أبا، وصغيرهم ابنا، وأوسطهم أخا، وإن من حسن الخلق تهذيب الألفاظ وحسن المعاشرة ولطف المعشر والبعد عن السفه ومجانبة ما لا يليق ولا يجمل ولا يسمع لصاحبه في المجالس عيبة ولا تحفظ له زلة ولا سقطة، فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما “القصد والتؤدة وحسن السمت جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة”
وإن ذو الأخلاق الفاضلة تجده وقورا رزينا، ذا سَكينة وتؤدة، عفيفا نزيها، لا جافيا ولا لعانا، لا صخّابا ولا صياحا، لا عَجولا ولا فاحشا، يقابل تصرفات الناس نحوه بما هو أحسن وأفضل وأقرب منها إلى البر والتقوى، وأشبه بما يُحمد ويرضى، وإن من أعظم أنواع الخلق الحسن، هو خلق الحياء في الأقوال والأفعال، ولقد كثرت الفتن في هذا الزمان، وأصبح المسلم يرى الفتن بكرة وعشيا، وحلّ من البلايا والمحن والنوازل والخطوب الجسام الشيء الكثير، وما ذاك إلا بسبب ما آل إليه حال المسلمين من ضياعٍ وتشتت، وبُعدهم عن منهج الإسلام، وتفشي المنكراتِ بينهم، فتسلطت عليهم الأمم الكافرة، واستباحت بيضتهم، وإن أول ما يُعتصم به من الفتن هو كتاب الله عز وجل، وسُنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا نجاة للأمة من الفتن والشدائد إلا بالاعتصام بهما، ومن تمسك بهما أنجاه الله تعالى، ومن دعا إليهما هُدِى إلى صراط مستقيم.